

 |
 |
 المناسبات
المناسبات |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مشرفة قسم القرآن
      
|
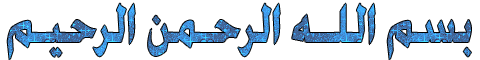 {المص (1)} قبل أن نبدأ خواطرنا في سورة الأعراف لابد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في كتاب الله، الله يقول: {إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الانعام: 165]. ونقرأ الكلمة الأخيرة في سورة الأنعام {رَّحيِمٌ}، ونجدها مبنية على الوصل؛ لأن آيات القرآن كلها موصولة، وإن كانت توجد فواصل آيات، إلا أنها مبنية على الوصل، ولذلك تجد {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وعليها الضمة وبجوارها ميم صغيرة؛ لأن التنوين إذا جاء بعده باء، يقلب التنوين ميماً، فالميم الصغيرة موجودة على رحيم، قبل أن تقرأ {بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ}، وتصبح القراءة: (غفور رحيم) (بسم الله). وكل آيات القرآن تجدها مبنية على الوصل، فكأن القرآن ليس أبعاضاً. وكان من الممكن أن يجعلها سكوناً، وأن يجعل كل آية لها وقف، لا، إنّه سبحانه أراد القرآن موصولاً، وإن كان في بعض الآيات إقلاب، وفي بعضها إدغام، وهذا بغُنَّة، وهذا بغير غُنَّة، ويقول الحق: {المص} وفي هذه الآية فصل بين كل حرف، فنقرأها: (ألف) ثم نسكت لنقرأ (لام) ثم نسكت لنقرأ (ميم) ثم نسكت لنقرأ (صاد). وهنا حروف خرقت القاعدة لحكمة؛ لأن هذه حروف مقطعة، مثل (الم، حم، طه، يس، ص، ق) وكلها مبنية على السكون مما يدل على أن هذه الحروف وإن الحروف وإن خيل لك أنها كلمة واحدة، لكن لكل حرف منها معنى مستقل عند الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنةٌ، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن أَلِفٌ حرف، ولامٌ حرف، وَمِيمٌ حرف». والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه الحروف بها أمور استقلالية، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقوف عليها، فهمها من فهمها، وتعبد بها من تعبد بها، وكل قارئ للقرآن يأخذ ثوابه بكل حرف، فلو أن قارئاً قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونطق بعد ذلك بحرف أو بأكثر، فهو قد أخذ بكل حرف حسنة، وحين نقرأ بعضاً من فواتح السور، نجد أن سورة البقرة تبدأ بقوله الحق: {الم} [البقرة: 1]. ونقرأ هنا في أول سورة الأعراف: {المص} [الأعراف: 1]. وهي حروف مقطعة. نطقت بالإِسكان، وبالفصل بين كل حرف وحرف. ويلاحظ فيها أيضاً أنها لم تقرأ مسميات، وإنما قُرئت أسماء، ما معنى مسميات؟ وما معنى أسماء؟. أنت حين تقول: كتب، لا تقول(كاف)(تاء)(باء) ، بل تنطق مسمى(الكاف)(كَ)، واسمها كاف مفتوحة، أما مسماها فهو(كَ) . إذن فكل حرف له مسمى، أي الصوت الذي يقوله الإِنسان، وله اسم، والأمي ينطق المسميات، وإن لم يعرف أسماءها. أما المتعلم فهو وحده الذي يفهم أنه حين يقول: (كتب) أنها مكونة من كاف مفتوحة، وتاء مفتوحة، وباء مفتوحة، أما الأمي فهو لا يعرف هذا التفصيل. وإذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال: ألف لام ميم، وهو أمي لم يتعلم. فمن قال له انطق مسميات الحروف بهذه الأسماء؟. لابد أنه قد عُلَّمَهَا وتلقاها، والحق هو القائل: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتبع قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]. فالذي سوف تسمعه يا محمد ستقرأه، ولذلك تجد عجائب؛ فأنت تجد (ألم) في أول البقرة، وفي أول سورة آل عمران، ولكنك تقرأ الآية الأولى من سورة الفيل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفيل} [الفيل: 1]. ما الفرق بين الألف واللام والميم في أول سورة البقرة، وسورة آل عمران وغيرهما، والحروف نفسها في أول سورة الفيل وغيرها كسورة الشَّرْح؟ أنت تقرأها في أول سورة البقرة وآل عمران أسماء. وتقرأها في أول سورة الفيل مسميات. والذي جعلك تفرق بين هذه وتلك أنك سمعتها تقرأ في أول البقرة وآل عمران هكذا، وسمعتها تقرأ في أول سورة الفيل هكذا. إذن فالقراءة توقيف، وليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم. لا، لابد أن يسمعه أولاً حتى يعرف كيف يقرأ. ونقرأ {المص} في أول سورة الأعراف، وهي حروف مقطعة، ونعرف أن الحروف المقطعة ثمانية وعشرون حرفاً، ونجد نصفها أربعة عشر حرفاً في فواتح السور، وقد يوجد منها في أول السورة حرف واحد مثل: {ق والقرآن المجيد} [ق: 1]. وكذلك قوله الحق: {ص والقرآن ذِي الذكر} [ص: 1]. وكذلك قوله الحق: {ن والقلم وَمَا يَسْطُرُونَ} [القلم: 1]. ومرة يأتي من الحروف المقطعة اثنان، مثل قوله الحق: {حم} [الأحقاف: 1]. ومرة تأتي ثلاثة حروف مقطعة مثل: {الم} [البقرة: 1]. ومرة يأتي الحق بأربعة حروف مقطعة مثل قوله الحق: {المص} [الأعراف: 1]. ومرة يأتي بخمسة حروف مقطعة مثل قوله الحق: {كهيعص} [مريم: 1]. وإذا نظرت إلى الأربعة عشر حرفاً وجدتها تمثل نصف الحروف الأبجدية، وهذا النصف فيه نصف أحكام الحروف، فبعضها منشور، أو مهموس، أو مخفي، أو مستعلٍ، ومن كل نوع تجد النصف، مما يدل على أنها موضوعة بحساب دقيق، ومع أن توصيف الحروف، من مستعل، أو مفخم، أو مرقق، أو منشور، أو مهموس، هذا التوصيف جاء متأخراً عن نزول القرآن، ولكن الذي قاله يعلم ما ينتهي إليه خلقه في هذه الحروف المقطعة وله في ذلك حكمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميَّا، ولم يجلس إلى معلم، فكيف نطق بأسماء الحروف، وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم؟! فهو إذن قد تلقنها، وإننا نعلم أن القرآن جاء متحديَّا العرب؛ ليكون معجزة لسيد الخلق، ولا يُتَحَدَّى إلا من كان بارعاً في هذه الصنعة. وكان العرب مشهورين بالبلاغة، والخطابة والشعر، والسجع وبالأمثال؛ فهم أمة كلام، وفصاحة، وبلاغة، فجاء لهم القرآن من جنس نبوغهم، وحين يتحدى الله العرب بأنه أرسل قرآناً لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، فالمادة الخام- وهي اللغة- واحدة، ومن حروف اللغة نفسها التي برع العرب فيها. وبالكلمات نفسها التي يستعملونها، لكنهم عجزوا أن يأتوا بمثله؛ لأنه جاء من رب قادر، وكلام العرب وبلاغتهم هي من صنعة الإنسان المخلوق العاجز. وهكذا نعلم سر الحروف المقطعة التي جاءت لتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من الملأ الأعلى لأنه أمي لم يتعلم شيئاً، لكنه عرف أسماء الحروف، ومعرفة أسماء الحروف لا يعرفها- كما قلت- إلا المتعلم، وقد علمه الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، ويمكن للعقل البشري أن يحوم حول هذه الآيات، وفي هذه الحروف معان كثيرة، ونجد أن الكثير من المفكرين والمتدبرين لكلام الله وجدوا في مجال جلال وجمال القرآن الكثير، فتجد متصوفاً يقول إن (المص) جاءت هنا لحكمة، فأنت تنطق أو كلمة ألف وهي الهمزة من الحلق، واللام تنطقها من اللسان، والميم تنطقها من الشفة، وبذلك تستوعب مخارج الحروف من الحلق واللسان والشفة. قال المتصوف ذلك ليدلك على أن هذه السورة تتكلم في أمور الحياة بدءاً للخلق من آدم. إشارة إلى أولية خلق الإنسان، ووسطاً وهو المعاش، ونهاية وهو الموت والحساب ثم الحياة في الدار الأخرة، وجاءت (الصاد) لأن في هذه السورة قصص أغلب الأنبياء. هكذا جال هذا المتصوف جولة وطلع بها، أنردها عليه؟ لا نردها بطبيعة الحال، ولكن نقول له: أذلك هو كل علم الله فيها؟. لا؛ لأن علينا أن نتعرف على المعاني التي فيها وأن نأخذها على قدر بشريتنا، ولكن إذا قرأناها على قدر مراد الله فيها فلن نستوعب كل آفاق مرادات الله؛ لأن أفهامنا قاصرة. ونحن البشر نضع كلمات لا معنى لها لكي تدل على أشياء تخدم الحياة، فمثلا نجد في الجيوش من يضع (كلمة سر) لكل معسكر فلا يدخل إلا من يعرف الكلمة. من يعرف (كلمة السر) يمكنه أن يدخل. وكل كلمة سر لها معنى عند واضعها، وقد يكون ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الجيش ولا يعرفها. {المص} [الأعراف: 1]. ونجد بعد هذه الحروف المقطعة حديثاً عن الكتاب، فيقول سبحانه: {كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ...}.  {كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)} وساعة تسمع (أنزل) فافهم أنه جاء من جهة العلو أي أن التشريع من أعلى. وقال بعض العلماء: وهل يوجد في صدر رسول الله حرج؟. لننتبه أنه ساعة يأتي أمر من ربنا ويوضح فيه {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ}، فالنهي ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما النهي للحرج أو الضيق أن يدخل لرسول الله، وكأنه سبحانه يقول: يا حرج لا تنزل قلب محمد. لكن بعض العلماء قال: لقد جاء الحق بقوله سبحانه: {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ}؛ لأن الحق يعلم أم محمداً قد يضيق صدره ببشريته، ويحزن؛ لأنهم يقولون عليه ساحر، وكذاب، ومجنون وإذا ما جاء خصمك وقال فيك أوصافاً أنت أعلم منه بعدم وجودها فيك فهو الكاذب؛ لأنك لم تكذب ولم تسحر، وتريد هداية القوم، وقوله سبحانه: {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ} قد جاء لأمر من اثنين: إما أن يكون الأمر للحرج ألا يسكن صدر رسول الله، وإما أن يكون الأمر للرسول طمأنة له وتسكينا، أي لا تتضايق لأنه أنزل إليك من إله، وهل ينزل الله عليك قرآناً ليصبح منهج خلقه وصراطاً مستقيماً لهم، ثم يسلمك إلى سفاهة هؤلاء؟ لا، لا يمكن، فاطمئن تماماً. {... فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 2]. والإِنذار لا يكون إلا لمخالف؛ لأن الإِنذار يكون إخباراً بشر ينتظر من تخاطبه. وهو أيضاً تذكير للمؤمنين مثلما قال من قبل في سورة البقرة: {... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} وهنا نلاحظ ان الرسالات تقتضي مُرْسِلاً أعلى وهو الله، ومُرَسَلاً وهو الرسول، ومُرْسَلاً إليه وهم الأمة، والمرسَل إليه إما أن يستمع ويهتدي وإما لا، وجاءت الآية لتقول: {كِتَابٌ أُنزِلَ} من الله وهو المرسِل، و(إليك) لأنك رسول والمرسَل إليهم هم الأمة، إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم وتهديهم وتعينهم أو تبشرهم إن كانوا مؤمنين.  {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3)} وما دام العباد سينقسمون أمام صاحب الرسالة والكتاب الذي جاء به إلى من يقبل الهداية، ومن يحتاج إلى النذارة لذلك يقول لهم: {اتبعوا ما أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ} [الأعراف: 3]. وينهاهم عن الشرك وعدم الاستهداء أي طلب الهداية فيقول: {وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]. وحينما يأتي الحق سبحانه في مثل هذه الآيات ويقول: (وذكرى). أو (وذكِّر) إنما يلفتنا إلى أن الفطرة المطبوع عليها الإِنسان مؤمنة، والرسالات كلها لم تأت لتنشئ إيماناً جديداً، وإنما جاءت لتذكر بالعهد الذي أخذ علينا أيام كنا في عالم الذر، وقبل أن يكون لنا شهوة اختيار: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلى شَهِدْنَآ...} [الأعراف: 172]. هذا هو الإقرار في عالم الذر، إذن فحين يقول الحق: {قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} فنحن نلتفت إلى ما نسي الآباء أن يبلغوه للأبناء؛ فالآباء يعلمون الأبناء متطلبات حياتهم، وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة التي تلقوها؛ لأن آدم وحواء ما نزلا إلى الأرض قال لهما الحق: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتبع هُدَايَ...} [طه: 123]. وهكذا نعلم أن هناك (هدى) قد نزل على آدم، وكان من الواجب على آدم أن يعلمه للأبناء، ويعلمه الأبناء للأحفاد، وكان يجب أن يظل هذا (الهدى) منقولاً في سلسلة الحياة كما وصلت كل أقضية الحياة. ويأتي سبحانه لنا بحيثيات الاتباع. {اتبعوا ما أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ...} [الأعراف: 3]. فالمنهج الذي يأتي من الرب الأعلى هو الذي يصلح الحياة، ولا غضاضة على أحد منكم في أن يتبع ما أنزل إليه من الإله المربي القادر. الذي ربّى، وخلق من عدم، وأمد من عدم، وهو المتولي للتربية، ولا يمكن أن يربي أجسادنا بالطعام والشراب والهواء ولا يربي قيمنا بالأخلاق. {وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ}. ومادام قد أوضح: اتبعوا ما أنزل إليكم من أعلى، فلا يصح أن تأتي لمن دونه وتأخذ منه، مثلما يفعل العالم الآن حين يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى البشر. فها يحب الرأسمالية فيفرضها بالسيف، وآخر يحب الاشتراكية فيفرضها البشر. بالسيف. وكل واحد يفرض بسيفه القوانين التي تلائمه. وكلها دون منهج الله لأنها أفكار بشر، وتتصادم بأفكار بشر، والأولى من هذا وذاك أن نأخذ مما لا نستنكف أن نكون عبيداً له. {... وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]. وتذكر أيها المؤمن أن عزتك في اتباع منهج الله تتجلّى في أنك لا تخضع لمساوٍ لك، وهذه ميزة الدين الذي يجعل الإنسان يحيا في الكون وكرامته محفوظةً، وإن جاءته مسألة فوق أسبابه يقابلها بالمتاح له من الأسباب مؤمناً بأن رب الأسباب سيقدم له العون، ويقدم الحق له العون فعلاً فيسجد لله شاكراً، أما الذي ليس له رب فساعة أن تأتي له مسألة فوق أسبابه تضيق حياته عليه وقد ينتحر. ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات سائر من لدن آدم، وكلما طرأت الغفلة على البشر أرسل الله رسولاً ينبههم. ويوقظ القيم والمناعة الدينية التي توجد في الذات، بحيث إذا مالت الذات إلى شيء انحرافي تنبه الذات نفسها وتقول: لماذا فعلت هكذا؟. وهذه هي النفس اللوامة. فإذا ما سكتت النفس اللوامة واستمرأ الإنسان الخطأ، وصارت نفسه أمارة بالسوء طوال الوقت؛ فالمجتمع الذي حوله يعدله. وهذه فائدة التواصي بالحق والصبر، فكل واحد يوصَّى في ظرف، ويوصِّي في ظرف آخر؛ فحين تضعف نفسه أمام شهوة يأتي شخص آخر لم يضعف في هذه الشهوة وينصح الإنسان، ويتبادل الإنسان النصح مع غيره، هذا هو معنى التواصي؛ فالوصية لا تأتي من جماعة تحترف توصية الناس، بل يكون كل إنسان موصياً فيما هو فيه قوي، ويوصي فيما هو فيه ضعيف، فإذا فسد المجتمع، تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة، ومنهج جديد، لكن الله أمن أمة محمد على هذا الأمر فلم يجيء رسول بعده لأننا خير أمة أخرجت للناس. والخيرية تتجلى في أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فالتواصي باقٍ إلى أن تقوم الساعة. {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر...} [آل عمران: 110]. وهذه خاصية لن تنتهي أبداً، فإن رأيت منكراً فلابد من خلية خير تنكره وتقول: لا، وإذا كان الحق قد جعل محمداً خاتم الرسل، فذلك شهادة لأمته أنها أصبحت مأمونة، وأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع وتنقطع، وكذلك لا تمتنع منها أبداً المناعة الاجتماعية فلن يأتي رسول بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4)} وساعة تسمع (كم) فاعرف أن المسألة خرجت عن العد بحيث تستوجب أن تستفهم عنها، وهذا يدل على أمر كثير فوق العدد، لكن عندما يكون العدد قليلاً فلا يستفهم عنه، بل يعرف. والقرية اسم للمكان المعد إعداداً خاصاً لمعيشة الناس فيه. وهل القرى هي التي تهلك أم يهلك من فيها؟. أوضح الحق أنها تأتي مرة ويراد منها المكان والمكين: أو يكون المراد بالقرية أهلها، مثال ذلك قوله الحق في سورة يوسف: {وَسْئَلِ القرية التي كُنَّا فِيهَا والعير...} [يوسف: 82]. وبطبيعة الحال لن يسأل إنسان المكان أو المباني، بل يسأل أهل القرية، ولم يقل الحق: اسأل أهل القرية؛ لأن المسئول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن المكان يشهد مع المكين، ومرة أخرى يوضح الحق أنه يدمر القرية بسكانها ومبانيها. {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا}. وأيهما يأتي أولاً: الإهلاك أم يأتي البأس أولاً فيهلك؟. الذي يأتي أولاً هو البأس فيهلك، فمظاهر الكونيات في الأحداث لا يأتي أمرها ارتجالاً، وإنما أمرها مسبق أزلاً، وكأن الحق يقول هنا: وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا ليتحقق ما قلناه أزلاً، أي أن تأتي الأحداث على وفق المرادات؛ حتى ولو كان هناك اختيار للذي يتكلم عنه الحق. ونعلم أن القرية هي المكان، وعلى ذلك فليس لها اختيار. وإن كان لمن يتحدث عنه الله حق الاختيار، فسبحانه يعلم أزلاً أنه سيفعل ما يتحدث عنه سبحانه. ويأتي به في قرآن يتلى؛ ليأتي السلوك موافقاً ما أخبر به الله. {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} [الأعراف: 4]. والبأس هو القوة التي ترد ولا تقهر، و(بيتاً) أي بالليل، {أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} أي في القيلولة. ولماذا يأتي البأس في البيات أو في القيلولة؟. ونجد في خبر عمّن أَهْلِكُوا مثل قوم لوط أنّه حدث لهم الهلاك بالليل، وقوم شعيب حدث لهم الهلاك في القيلولة، والبيات والقيلولة هما وقت الاسترخاء ووقت الراحة وتفاجئهم الأحداث فلا يستطيعون أن يستعدوا. {فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ المنذرين} [الصافات: 177]. أي يأتيهم الدمار في وقت هم نائمون فيه، ولا قوة لهم لمواجهة البأس. {... فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} [الأعراف: 4]. وإذا قال سبحانه: {بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} فيصح أن لهذه القرية امتدادات، ووقت القيلولة عند جماعة يختلف عن وقت من يسكن امتداد القرية، فيكون الوقت عندهم ليلاً، والقيلولة هي الوقت الذي ينامون فيه ظهراً للاسترخاء والراحة. ولكن كيف استقبلوا ساعة مجيء البأس الذي سيهلكهم؟.  {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5)} بهذا القول اتضحت المسألة، ومن قوله {دَعْوَاهُمْ} نفهم أن المسألة ادعاء. ونحن نقول: فلان ادّعى دعوى على فلان، فإما أن يقيم بينة ليثبت دعواه، وإما ألاّ يقيم. والدعوى تطلق أيضاً على الدعاء: {... وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} [يونس: 10]. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ إِلاَّ أَن قالوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} [الأعراف: 5]. ويشرح ربنا هذا الأمر في آيات كثيرة، إنه اعتراف منهم باقترافهم الظلم وقيامهم عليه، فسبحانه القائل: {وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السعير فاعترفوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السعير} [الملك: 10-11].  {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)} والحق يسأل الرسل بعد أن يجمعهم عن مدى تصديق أقوامهم لهم، والسؤال إنما يأتي للإِِقرار، ومسألة السؤال وردت في القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها متعارضة، والحقيقة أن جهاتها منفكة، وهذا ما جعل خصوم القرآن يدعون أن القرآن فيه تضارب. فالحق سبحانه يقول: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصور فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} [المؤمنون: 101]. ويقول سبحانه أيضاً {وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً} [المعارج: 10]. ويقول جل وعلا: {... وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون} [القصص: 78]. ويقول سبحانه وتعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ} [الرحمن: 39]. ثم يقول هنا: {فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين} [الأعراف: 6]. وهذا ما يجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقرآن- والعياذ بالله- متناقضات. ونقول لكل منهم: أنت تأخذ القرآن بغير ملكة البيان في اللغة، ولو أنك نظرت إلى أن القرآن قد استقبله قوم لسانهم عربي، وهم باقون على كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا يجاملون، ولو أنهم وجدوا هذا التناقض، أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا: أيكون القرآن معجزا وهو متعارض؟! لكن الكفار لم يقولوها، مما يدل على أن ملكاتهم استقبلت القرآن بما يريده قائل القرآن. وفي أعرافنا نورد السؤال مرتين؛ فمرة يسأل التلميذ أستاذه ليعلم، ومرة يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر. إذن فالسؤال يأتي لشيئين اثنين: إما أن تسأل لتتعلم، وهذا هو الاستفهام، وإما أن تسأل لتقرر حتى تصبح الحجة ألزم للمسئول، فإذا كان الله سيسأله، أي يسأله سؤال إقرار ليكون أبلغ في الاحتجاج عليه، وبعد ذلك يقولون: {وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السعير فاعترفوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السعير} [الملك: 10-11]. وهذا اعتراف وإقرار منهم وهما سيدا الأدلة؛ لأن كلام المقابل إنما يكون شهادة، ولكن كلام المقر هو إقرار اعتراف. إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على أنفسهم، وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإِنكار. فإما أن يقر الإِنسان، وإن لم يقر فستقول أبعاضه؛ لأن الإِرادة انفكت عنها، ولم يعد للإِنسان قهر عليها، مصداقاً لقوله الحق: {وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَنَا الله الذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ...} [فصلت: 21]. والحق هنا يقول: {فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين}. وهو سؤال للإِقرار. قال الله عنه: {يَوْمَ يَجْمَعُ الله الرسل فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ...} [المائدة: 109]. وحين يسأل الحق المرسلين، وهم قد أدوا رسالتهم فيكون ذلك تقريعاً للمرسَل إليهم.  {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7)} أي سيخبرهم بكل ما عملوا في لحظة الحساب؛ لأنه سبحانه لم يغب يوماً عن أي من خلقه؛ لذلك قال: {وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ}، ونعلم أن الخلق متكرر الذوات، متكرر الأحداث، متكرر المواقع، هم ذوات كثيرة، وكل ذات لها حدث، وكل ذات لها مكان. فإذا قال الحق للجميع: {وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} أي أنه مع الجميع، ومادام ليس بغائب عن حدث، ولا عن فاعل حدث، ولا عن مكان حدث، وهؤلاء متعددون. إذن هو في كل زمان وفي كل مكان. وإن قلت كيف يكون هنا وهناك؟ أقول: خذ ذلك في إطار قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، ومثل هذه المعاني في الغيبيات لا يمكن أن تحكمها هذه الصور. والأمر سبق أن قلناه حين تحدثنا عن مجيء الله؛ فله طلاقة القدرة وليس كمثله شيء، وما كان غائباً في حدث أو مكان.  {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8)} في هذه الآيات نجد الحديث عن الوزن للأعمال، وهذا كله تأكيد للحجة عليهم؛ فالله لا يظلم أحداً، وفي وزن الأعمال إبطال للحجة من الذين يخافون النار، ولم يؤدوا حقوق الله في الدنيا، وكل ذلك ليؤكد الحجة، ويظهر الإنصاف ويقطع العذر، وهنا قول كريم يقول فيه الحق سبحانه: {وَنَضَعُ الموازين القسط لِيَوْمِ القيامة...} [الأنبياء: 47]. هذه الموازين هي عين العدل، وليست مجرد موازين عادلة، بل تبلغ دقة موازين اليوم الآخر أنها هي عدل في ذاتها. وهنا يقول الحق: {والوزن يَوْمَئِذٍ الحق}. نعم، الميزان في هذا اليوم حق ودقيق، لنذكر انه قال من قبل: {مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بالسيئة فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160]. والميزان الحق هو الذي قامت عليه عدالة الكون كله، وكل شيء فيه موزون، وسبحانه هو الذي يضع المقادير على قدر الحكمة والإِتقان والدقة التي يؤدي بها كل كائن المطلوبَ منه، ولذلك يقوله سبحانه: {والسمآء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميزان} [الرحمن: 7]. ولم نر السماء قذفت وألقت علينا أحداثاً غير متوقعة منها، فالكون له نظام دقيق. والوزن في يوم القيامة هو مطلق الحق، ففي هذا اليوم تبطل موازين الأرض التي كانت تعاني إما خللاً في الآلة التي يوزن بها، وإمّا خللاً في الوزن، وإمّا أن تتأثر بأحداث الكون، وما يجري فيه من تفاعلات، أما ميزان السماء فلا دخل لأحد به ولا يتأثر إلا بقيمة ما عمل الإِنسان، وساعة يقول سبحانه: {والوزن يَوْمَئِذٍ الحق}. فكأن الميزان في الدنيا يمكن أن يحصل فيه خلل، وكذلك المِلْك أيضاً؛ لأنه سبحانه أعطى أسباباً للملك المناسب لكل إنسان، فهذا يملك كذا، والثاني يملك كذا، والثالث يملك كذا، وبعد ذلك يتصرف كل إنسان في هذا الملك إن عدلاً، وإن ظلماً على ضوء الاختيار. لكن حين يأتي اليوم الآخر فلا ملك لأحد: {... لِّمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار} [غافر: 16]. فالأمر حينئذ يكون كله لله وحده، فإن كان الملك في الدينا قد استخلف فيه الحق عباده، فهذه الولاية تنتهي في اليوم الآخر: {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فأولئك هُمُ المفلحون}. وسبحانه هو القائل: {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارعة: 6-11]. إذن فالميزان يثقل بالحسنات، ويخف بالسيئات، ونلحظ أن القسمة العقلية لإِيجاد ميزان ووزان وموزون تقتضي ثلاثة أشياء: أن تثقل كفة، وتخف الأخرى، أو أن يتساويا، ولكن هذه الحال غير موجودة هنا. ويتحدث الحق عن الذين تخف موازينهم فيقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ...}.  {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)} والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين، وفي هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين، ومن العجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثالثة وهي حالة تساوي الكفتين يأتي في أول سورة الأعراف، ولكنه- سبحانه يقول بعد ذلك في سورة الأعراف: {وَعَلَى الأعراف رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ}. وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقد جعل لهم ربنا مكاناً يشبه عرف الفرس، وعرف الفرس يعتبر أعلى شيء فيه، فحينا يأتي شعر الفرس يميناً، وحينا يأتي شعر الفرس يساراً، وليس هناك جهة أولى بالشعر من الأخرى. وقد أعد الحق لأصحاب الأعراف مكاناً يسمعون فيه أصحاب النار وهم ينادون أصحاب الجنة، وأصحاب الجنة وهم ينادون أصحاب النار، وأصحاب الأعراف يجلسون؛ لا هم في الجنة ولا هم في النار، فهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الأعراف رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} [الأعراف: 46]. فلا الحسنات ثقلت ليدخلوا الجنة، ولا السيئات خفت ليدخلوا النار، فميزانهم تساوت فيه الكفتان. وقال بعض العلماء عن الميزان؛ إن هناك ميزاناً بالفعل. وقال البعض إن المراد بالميزان هو العدالة المطلقة التي أقامها العادل الأعلى، والأعجب أن الحق قال: إن هناك موازين، فهل لكل واحد ميزان أو لكل عمل من أعمال التكليفات ميزان: ميزان العقائد، وميزان الأحكام.. إلخ، وهل سيحاسبنا ربنا تباعاً. أو أن هناك موازين متعددة، بدليل أن سيدنا الإِمام عليًّا عندما سألوه: أيحاسب الله خلقه جميعاً في وقت واحد؟ فقال: وأي عجب في هذا؟ أليس هو رازقهم في وقت واحد؟ إذن فالميزان بالنسبة لله مسألة سهلة جدًّا. وهيّنة فسبحانه لا يتأبى عليه شيء. {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأولئك الذين خسروا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ} [الأعراف: 9]. نعم هم قد خسروا أنفسهم فكل منهم كان يأخذ شهوات ويرتكب سيئات يمتع بها نفسه، ويأتي اليوم الآخر ليجد نفسه قد خسر كل شيء، وكما يقول المثل العام: خسر الجلد والسقط. لماذا؟ تأتي الإِجابة من الحق: {... بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ}.  {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10)} المُمَكَّن هو الذي يحتل المكان بدون زحزحة؛ فيقال مكّنتك من كذا. أي أعطيتك المكان ولا ينازعك أحد فيه. وقد مكننا سبحانه في الأرض وجعل لنا فيها وسائل استبقاء الحياة، وترف الحياة، وزينة الحياة، ورياش الحياة، ولم تبخل الأرض حين حرثناها، بل أخرجت لنا الزرع، ولم تغب الشمس عنا بضوئها وإشعاعها وحراراتها. ما في الدنيا يؤدي مهمته، ولم نُمكَّن في الأرض بقدراتنا بل بقدرة الله. وكان يجب ألا يغيب ذلك عن أنظارنا أبداً. فلا أحد منا مسيطر على الشمس أو القمر أو الريح أو الأرض، ولكن الذي خلقها وجعلها مسخرة، هو ربك وربها؛ فأنت مُمَكَّن، وكل شيء مستجيب لك. بتسخير الله له. {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} [الأعراف: 10]. و(معايش) جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، فالعيش هو مقومات الحياة، ولذلك سموا الخبز في القرى عيشاً لأن عندهم دقة بالغة؛ لأنهم عرفوا أنه مقوّم أساسي في الحياة. وقول الحق: {قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}دل على أن هناك من يشكر، ومن الناس من يشكر نعم الله شكراً عاماً على مجموع النعم، أو يشكره شكراً خاصًّا عند كل نعمة، ومنهم من يشكر شكراً خاصًّا لا عند كل نعمة، ولكن عند جزئيات النعمة الواحدة فعندما يبدأ في الأكل يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ويقول بعد الأكل: (الحمد لله)؛ وهناك من يقول عند تناول لقمة واحدة: (بسم الله) وعندما يمضغها ويبلعها يقول: (الحمد لله) لأنها لم تقف في حلقه، وأيضاً حين نشرب علينا أن نشرب على ثلاث دفعات: أول دفعة نقول: (بسم الله). وننتهي منها فنقول: (الحمد لله) وكذلك في الدفعة الثانية والدفعة الثالثة. ومن يفعل ذلك فلا تتأتَّى منه معصية، مادامت آثار شربة الماء هذه في جسمه؛ لأنها كلها (بسم الله). فتحرسه من الخطيئة؛ لأن النعمة الواحدة لو استقصيتها لوجدت فيها نعما كثيرة. وأنتم حين لا تشكرون إنما تضيقون عليكم أبواب النعم من الله؛ لأنكم لو شكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم، {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} ومن الحمق ألا نشكر.  {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11)} ومسألة الخلق سبق أن تقدمت في سورة البقرة: خلق آدم، والشيطان، والقضية تتوزع على سبع سور، في سبعة مواضع موجودة في سورة البقرة، وسورة الأعراف، وسورة الحج، وسورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة طه، وسورة ص، إلا أن القصة في في كل موضع لها لقطات متعددة، فهنا لقطة، وهناك لقطة ثانية، وتلك لقطة ثالثة، وهكذا؛ لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله؛ لتستقر في أذهان عباده، ولو أنه ذكرها مرة واحدة فقد تُنسى، لذلك يعيد الله التذكير بها أكثر من مرة. وإذا أراد الله استحضار النعم والتنبيه عليها في أشياء، فهو يكررها كما كررها في استحضار النعم في سورة واحدة في قوله سبحانه: {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}. إنه يذكر هذه النعم من بدايتها، فيقول: {خَلَقَ الإنسان مِن صَلْصَالٍ كالفخار وَخَلَقَ الجآن مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الجوار المنشئات فِي البحر كالأعلام فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإكرام فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 14-28]. وكل نعمة يقول بعدها: {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} وأراد سبحانه بذلك أن يكثر ويردد تكرارها على الآذان لتستقر في القلوب حتى في الآذان الصماء؛ فمرة يأتي بها في شيء ظاهره أنه ليس نعمة، مثل قوله: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 35-36]. وجاء الحق بذكر كل ذلك؛ لأنه ساعة يجلي لنا الأمور على حقائقها ونحن في دار التكليف فهذه رحمة ونعمة منه علينا؛ لأن ذلك يدعونا إلى اتقاء المحظورات والبعد والتنحي عن المخالفات. ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد، فحين يدخل الابن إلى المدرسة نقول له: إن قصرت في كذا فسوف ترسب، وأنت بهذا القول ترحمه بالنصيحة، فلم تتركه دون أن تبصره بعواقب الأمور، وأيضا ساعة ترى شراً يحيق بالكافرين، فإن هذا الأمر يسرك، لأنه لو تساوى الكافرون مع المؤمنين لما كان للإيمان فضل أو ميزة، فالعذاب نقمة على الكافر، ونعمة على المقابل وهو المؤمن. وقد جاءت قصة خلق آدم بكل جوانبها في القرآن سبع مرات؛ لأنها قصة بدء الخلق، وهي التي تجيب عن السؤال الذي يبحث عن إجابته الإنسان؛ لأنه تلفت ليجد نفسه في كون معد له على أحسن ما يكون. ولم يجيء الكون من بعد الإنسان، بل طرأ الإنسان على الكون، وظل السؤال وارداً عن كيفية الخلق، والسؤال مهم أهمية وجود الإنسان في الكون، فأنت تستقرئ أجناساً في الكون، وكل جنس له مهمة، ومهمته متعلقة بك، جماد له مهمة، ونبات له مهمة، وحيوان له مهمة، وكلها تصب في خدمتك أنت؛ لأن الجماد ينفع النبات، ويتغذى منه لكي يغذي الحيوان، والحيوان ينفعك ويغذيك، إذن فكل الأجناس تصب في خدمتك. أمّا أنت أيها الإِنسان فما عملك في هذا الكون؟؛ لذلك كان لابد أن يتعرف الإِنسان على مهمته. وأراد الحق سبحانه أن يُعرِّف الإِنسان مهمته؛ لأنه جل وعلا هو الصانع، وحين يبحث الإِنسان عن صانعه تتجلى له قدرة الله في كل ما صنع. وكان لابد أيضاً أن يستقبل الإِنسان خبراً من الخالق. إنه- سبحانه- يُنزل لنا المنهج من السماء ويصاحب هذا المنهج معجزة على يد رسول، وأنزل الحق عليه المنهج وأوكل له مهمة البلاغ. فالرسول يخبر، ثم نستدل بالمعجزة على صدق خبره. فكان من اللازم أن نصدق الرسول، لأنه قادم بآية ومعجزة من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة في سن الأربعين ومعه المنهج المعجزة، وأبلغنا أنه رسول من الله. وكان لابد أن نبحث لنتثبت من صدق البلاغ عن الله بالتعقل في دعواه؛ فهذا الرسول جاء بعد أربعين سنة من ميلاده ومعه معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه، وليس من جنس ما نبغ فيه هو، إن معجزته ليست من عنده، بل هي من عند الله؛ لأن الرسول جاء بالمعجزة بعد أربعين سنة من ميلاده، ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد أربعين سنة من الميلاد؛ لأننا نعلم أن العبقريات تأتي في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث من عمر الإِنسان، ونلتفت فنجده يتكلم كل الكلام البلاغي المعجز. وليس من المعقول ان يأتي بأخبار الكون وهو الأمي الذي مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو في السادسة، وكذلك مات جده. ورأى الناس يتساقطون من حوله، فمن الذي أدراه- إذن- انه سيمهل ويمد في أجله إلى أن يصل إلى الأربعين ليبلغنا بمعجزته؟. ولذلك نجد القرآن يستدل على هذه، فيقول: {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ائت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هاذآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ إني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس: 15]. وهكذا تتجلى الحجة القوية من أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ بما يُوحَى إليه، ويتأكد ذلك مرة ثانية في قوله الحق: {قُل لَّوْ شَآءَ الله مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} [يونس: 16]. وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلقى الأمر من الله بأن يبيّن لهم: هل علمتم عني خلال عمري أني قلت شعراً أو حكمة أو جئتكم بمثل؟ إذن إن نحن عقلنا الأمر وتبصرنا وتأملنا دعواه لصدقنا أنه رسول الله، وأن المعجزة نزلت عليه من السماء. {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الساجدين} [الأعراف: 11]. وهكذا نرى أن مسألة الخلق والإِيجاد، كان يجب على العقل البشري أن يبحث فيها، ليعلم مهمته في الوجود. وحين يبحث فيها ليعلم مهمته في الوجود. يجب عليه أن يترك كل تخمين وظنٍ؛ لأن هذه المسألة لا يمكن أن تأتي فيها بمقدمات موجودة لتدلنا على كيفية خلقنا ولا لأي شيء ومهمة خلقنا! فكيفية الخلق كانت أمراً غيبيًّا وليس أمامنا ما نستقرئه لنصل إلى ذلك. وقد حكم الله في قضية الخلق، سواء أكان الأمر بالنسبة للسموات والأرض وما بينهما أم للإِنسان، وقد حكم سبحانه في هاتين القضيتين، ولا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله سبحانه، وأغلق باب الاجتهاد فيها، وكذلك باب التخمين، وسمى القائمين بكل بحث بشري في هذا المجال بأنهم ضالون مضللون، ولذلك قال ليحكم هذه القضية ويحسمها، ويريح العقول من أن تبحث فيها؛ قال: {ما أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المضلين عَضُداً} [الكهف: 51]. فكأن الذي يقول: كيف خلقت السموات والأرض وكيف خلق الإِنسان هو مضل؛ لأن الله لم يشهده، ولم يكن القائل عضداً لله ولا سنداً ولا شريكا له. وقص سبحانه علينا قصة خلق السموات والأرض وخلق الإِنسان، وهذه الآية تتعرض لخلق الإِنسان. ومن يبحث بحثاً استقرائيّاً ويرجع إلى الوراء فلابد أن يجد أن الأمر منطقي؛ لأن العالم يتكاثر، وتكاثره أمر مرئي، وليس التكاثر في البشر فقط، بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأخرى، نجد فيهم ظاهرة التكاثر نباتاً وحيواناً، وإذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن وجدنا العدد يقل عن التعداد الحالي وهو خمسة آلاف مليون، وكلما عدنا ورجعنا إلى الزمن الماضي يقل التعداد إلى أن نصل إلى اثنين؛ لأن الخلق إنما يأتي من اثنين، وحلّ الله لنا اللغز فقال: {الذي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا...} [النساء: 1]. وهذا كلام صحيح يثبته الإِحصاء وييقنه؛ لأن العالم يتكاثر مع مرور الزمن مستقبلا. {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً...} [النساء: 1]. وهذا كلام صادق. وسبحانه القائل: {وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ...} [الذاريات: 49]. وأبلغنا سبحانه بقصة خلق آدم، وكيفية خلق حوّاء فهل أخذ جزءًا من آدم وخلق منه حوّاء؟ قد يصح ذلك، أو خلق منها زوجها ويكون المقصود به أنه خلقها من الجنس نفسه وبالطريقة نفسها؟ وذلك يصح أيضا، فسبحانه قد اكتفى بذكر خلق آدم عن ذكر خلق حوّاء، وأعطانا النموذج في واحد، وقال: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}. و{مِنْهَا} في هذه الآية يحتمل أن تكون غير تبعيضية، مثلها مثل قوله الحق: (رسول من أنفسكم). فسبحانه لم يأخذ قطعة من العرب وقال: إنها (محمد)، بل جعل محمدًّا صلى الله عليه وسلم من الجنس نفسه خلقاً وإيجاداً، وسبحانه حين يتكلم هنا يقول للملائكة: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةً...} [البقرة: 30]. وهذا أول بلاغ، ثم اتبع ذلك: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ} [الحجر: 29]. إذن فقبل النفخ في الروح ستوجد تسوية، فلمن تحدث التسوية، ومن هو (المسوّى منه)؟. إن التسوية لآدم. وجاء القول بأنه من صلصال، ومن حمأ مسنون، ومن تراب، ومن طين؛ إنّها مراحل متعددة، فإن قال سبحانه عن آدم: إنه تراب، نقول: نعم، وإن قال: (من ماء) نقول: نعم، وإن قال (من طين) فهذا قول حق؛ لأن الماء حين يختلط بالتراب يصير طيناً. وإن قال: {مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ}، فهذا جائز؛ لأن الحمأ طينٌ اختمر فتغيرت رائحته ثم جف وصار صلصالاً. إذن فهي مراحل متعددة للخلق، ثم قال الحق: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي}. وهكذا تكتمل فصول الخلق، ثم قال: {فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ}. ويقول العلماء: إن المراد من السجود هو الخضوع والتعظيم، وليس السجود كما نعرفه، وقال البعض الآخر: المراد بالسجود هو السجود الذي نعرفه، وأن آدم كان كالقبلة مثل الكعبة التي نتجه إليها عند الصلاة. ولكنْ لنا هنا ملاحظة، ونقول: إننا لا نسجد إلا الله، ومادام ربنا قد قال: اسجدوا فالسجود هنا هو امتثال لأمر خالق آدم. والنية إذن لم تكن عبادة لآدم، ولكنها طاعة لأمر الله الأول. والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله؛ لأنه سبحانه سخر الكون كله لخدمة آدم، ومن الملائكة مدبرات أمر، ومنهم حفظة، ومنهم من هو بين يدي الله، فلم يكن السجود للملائكة خضوعاً من الملائكة لآدم، بل هو طاعة لأمر الله، ولذلك سجد من الملائكة الموكلون بالأرض وخدمة الإنسان، لكنْ الملائكة المقربون لا يدرون شيئاُ عن أمر آدم ولذلك يقول الحق لإِبليس: {... أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين} [ص: 75]. والمقصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم، فليس للملائكة العالين عمل مع آدم؛ لأن الأمر بالسجود قد صدر لمن لهم عمل مع آدم وذريته والذين يقول فيهم الحق سبحانه: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله...} [الرعد: 11]. وهناك الرقيب، والعتيد والقعيد. وفي كل ظاهرة من ظواهر الكون هناك ملك مخصوص بها، ويبلغنا الحق بمسألة الخلق، والخطاب لنا {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ} وهذا ترتيب اخباري، وليس ترتيباً للأحداث. أو أن الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعاً في خلق آدم، والعلم الحديث يعطينا أيضاً مؤشرات على ذلك، حين يأتون ببذرة ويكتشفون فيها كل مقومات الثمرة، وكذلك الحيوان المنوي توجد فيه كل صفات الإنسان. ولذلك نجدهم حين يدرسون قانون الوراثة يقولون: إن حياة كل منا تتسلسل عن آخر، فأنت من ميكروب أبيك، وقد نزل من والدك وهو حي، ولو أنه نزل ميتاً لما اتصل الوجود. ووالدك جاء من ميكروب جده وهو حي، وعلى ذلك فكل مكائن الآن فيه كائن الآن فيه جزئ حي من لدن آدم، لم يطرأ عليه موت في أي حلقة من الحلقات. إذن فكلنا كنا مطمورين في جزيئات آدم، وقال ربنا سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ...} [الأعراف: 172]. ونقول: صدق الحق فهو الخالق القادر على أن يخرجنا من ظهر آدم، وهكذا كان الخلق أولاً والتصوير أولاً، وكل ذلك في ترتيب طبيعي، وهو سبحانه له أمور يبديها ولا يبتديها، أي أنه سبحانه يظهرها فقط، فإذا خاطب آدم وخاطب ذريته فكأنه يخاطبنا جميعاً. {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الساجدين} [الأعراف: 11]. وعرفنا من هم الملائكة من قبل، وما هي علة السجود. {فسجدوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الساجدين}. والحق سبحانه يستثنيه بأنه لم يكن من الساجدين. وهذا دليل على أنه دخل في الأمر بالسجود، ولكن هل إبليس من الملائكة؟ لا؛ لأنك إذا جئت في القرآن ووجدت نصَّا يدل بالالتزام، ونصَّا يدل بالمطابقة والقطع فاحمل نص الالتزام على النص المحكم الذي يقطع بالحكم. وقد قال الحق في ذلك: {وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمََ فسجدوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ...} [الكهف: 50]. وفي هذا إخراج لإبليس من جنس الملائكية، وتقرير أنه من الجن، والجن كالإنس مخلوق على الاختيار، يمكنه أن يعصي يمكنه أن يطبع أو أن يعصي، إذن فقوله الحق: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}. يعني أن هذا الفسوق أمر يجوز منه؛ لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإن تساءل أحد: ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضمن الحديث عن الملائكة؟. نقول: هب أن فرداً مختاراً من الإِنس أو من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله، فأطاع الله كما يجب ولم يعص.. أليست منزلته مثل الملك بل أكثر من الملك، لأنه يملك الاختيار. ولذلك كانوا يسمون إبليس طاووس الملائكة، أي الذي يزهو في محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بمنهج الله، وترك اختياره، وأخذ مرادات الله فنفذها، فصار لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، وصار يزهو على الملائكة لأنهم مجبورون على الطاعة، لكنه كان صالحاً لأن يطيع، وصالحاً- أيضاً- لأن يعصي، ومع ذلك التزم، فأخذ منزلة متميزة من بين الملائكة، وبلغ من تميزه أنه يحضر حضور الملائكة. فلما حضر مع الملائكة جاء البلاغ الأول عن آدم في أثناء حضوره، وقال ربنا للملائكة: {اسجدوا لأَدَمَ}. وكان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر الطاعة، لكنه استنكف ذلك. وهب أنه دون الملائكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة، ألم يكن من الأجدر به وهو الأدنى أن يلتزم بالأمر؟ لكنه لم يفعل. ولأنه من الجن فقد غلبت عليه طبيعة الاختيار.  {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)} ثم قال كما يحكي القرآن الكريم: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً} [الإسراء: 61]. وهكذا كان الموقف استكباراً واستلاءً. وقوله الحق: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ} [ص: 75]. ونحن حين نحلل هذا النص، نجد قوله: {مَا مَنَعَكَ} أي ما حجزك، وقد أورد القرآن هذه المسألة بأسلوبين، فقال الحق مرة: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ}. وقال مرة أخرى: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ}. وهذا يعني أن الأسلوب الأول جاء ب (لا) النافية، والأسلوب الثاني جاء على عدم وجود (لا) النافية. وقوله {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ} كلام سليم واضح؛ يعني: ما حجزك عن السجود. لكن {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} هي التي تحتاج لوقفة. لذلك قال العلماء: إن (لا) هنا زائدة، ومَنْ أَحْسَن الأدب منهم قال: إن (لا) صلة. لكن كلا القولين لا ينفع ولا يناسب؛ لأن من قال ذلك لم يفطن إلى مادة (منع) ولأي أمر تأتي، وأنت تقول: (منعت فلاناً أن يفعل)، كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته. إذن {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ} كأنّه كان عنده تهيؤ للسجود، فجاءت قوة أقوى منه ومنعته وحجزته وحالت بينه وبين أن يسجد. لكن ذلك لم يحدث. وتأتي (منع) للامتناع بأن يمتنع هو عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بترك السجود فيقتنع ويمتنع، وهناك فرق بين ممنوع، وممتنع؛ فممنوع هي في {مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ}، وممتنع تعني أنه امْتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكنّه أقنعه. وإن كان المنع من الامتناع فالأسلوب قد جاء ليؤكد المعنى الفعلي وهو المنع عن السجود. وهذا هو السبب في وجود التكرار في القرآن. ولذلك قال الحق سبحانه: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12]. وسبحانه قد أمر الملائكة وكان موجوداً معهم إما بطريق العلو، لأنه فاق الملائكة وأطاع الله وهو مختار فكانت منزلته عالية، وإما بطريق الدنو؛ لأن الملائكة أرفع من إبليس بأصل الخلقة والجبلة، وعلى أي وضع من العلو والدنو كان على إبليس أن يسجد، ولكنه قال في الرد على ربّه: {... أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} [الأعراف: 12]. وسبحانه لم يسأل إبليس عن المقارنة بينه وبين آدم، ولكن سأله وهو يعلم أزلاً أنّ إبليس قد امتنع باقتناع لا بقهر، ولذلك قال إبليس: أنا خير منه، فكأن المسألة دارت في ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود. ولا يصح في عرفه الإبليسي أن يسجد الأعلى للأدنى، فما دام إبليس يعتقد أنه خير من آدم ويظن أنه أعلى منه، فلا يصح أن يسجد له. وأعلى منه لماذا؟ لأنه قال: {خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} فكأن النار لها علو، وهو في ذلك مخطئ تماماً لأن الأجناس حين تختلف؛ فذلك لأن لكل جنس دوره، ولا يوجد جنس أفضل من جنس، النار لها مهمة، والطين له مهمة، والنار لا تقدر أن تؤدي مهمة الطين، قلا يمكن أن نزرع في النار. إذن فالخيرية تتأتى في الأمرين معا مادام كل منهما يؤدي مهمته، ولذلك لا تقل: إن هذا خير من هذا، إنما قل: عمل هذا أحسن من عمل هذا، فكل شيء في الوجود حين يوضع في منزلته المرادة منه يكون خيراً، ولذلك أقول: لا تقل عن عود الحديد إنه عود مستقيم، وتقول عن الخطاف: إن هذا عود أعوج، لأن مهمة الخطاف تقتضي أن يكون أعوج، وعوجه هو الذي جعله يؤدي مهمته، لأن الخيرية إنما تتأتى في متساوي المهمة، ولكن لإبليس قال: {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ...} [الأعراف: 12]. قالها للمعاندة، للكبر، للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله في أمره، وكأنه يخطِّئ الحق في أمره، ويردّ الأمر على الآمر. فما كان جزاء الحق سبحانه وتعالى لإبليس إلا أن قال له: {قَالَ فاهبط...}.  {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13)} والهبوط يستدعي الانتقال من منزلة عالية إلى منزلة أقل، وهذا ما جعل العلماء يقولون إن الجنة التي وصفها الله بأنها عالية في هي السماء، ونقول: لا، فالهبوط لا يستدعي أن يكون هبوطاً مكانياً، بل قد يكون هبوط مكانة، وهناك فرق بين هبوط المكان، وهبوط المكانة، وقد قال الحق لنوح عليه السلام: {قِيلَ يانوح اهبط بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وعلى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ...} [هود: 48]. أي اهبط من السفينة، إذن مادة الهبوط لا تفيد النزول من مكان أعلى إلى مكان أدنى، إنما نقول من مكان أو من مكانة. {قَالَ فاهبط مِنْهَا}. وهذا تنزيل من المكانة لأنه لم يعد أهلاً لأن يكون في محضر الملائكة؛ فقد كان في محضر الملائكة؛ لأنه الزم نفسه بالطاعة، وهو مخلوق على أن يكون مختارا أن يطيع أو أن يعصي، فلما تخلت عنه هذه الصفة لم يعد أهلاً لأن يكون في هذا المقام، وذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. {قَالَ فاهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ...} [الأعراف: 13]. أي ما ينبغي لك أن تتكبر فيها. إن امتناعك عن أمر من المعبود وقد وجهه لك وأنت العابد هو لون من الكبرياء على الآمر، والملائكة جماعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما دامت أنت أهل استكبار واستعلاء على هذه المكانة فلست أهلاً لها، فكأن العمل هو الذي أهله أن يكون في العلو، فلما زايله وفارقه كان أهلاً لأن يكون في الدنو، وهكذا لم يكن الأمر متعلقاً بالذاتية، وفي هذا هبوط لقيمة كلامه في أنه من نار وآدم من طين؛ لأن المقياس الذي توزن به الأمور هو مقياس أداء العمل، ومن حكمة الحق أن الجن يأخذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس، مثل السرعة، واختراق الحواجز، والتغلب على بعض الأسباب، فقد ينفذ الجن من الجدار أو من الجسم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم.». وهو ذلك مثل الميكروب، لأنه هذه طبيعة النار، وهي المادة التي خُلق منها. وهي تتعدى الحواجز. والجن قد بلغ من اللطف والشفافية أنه يقدر على أن ينفذ من أي شيء، لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح للجن لا تعتقد أن عنصريتك هي التي أعطتك هذا التمييز، وإنما هي إرادة المُعَنْصر، بدليل أنه جعلك أدنى من مكانة الإنسان، إنه- سبحانه- يجعل إنسياً مثل سيدنا سليمان مخدوما لك أيها الجنى، إنه يسخرك ويجعلك تخدمه. وأنه في مجلس سليمان، جعل الذي عنده علم من الكتاب، يأتي بقوة أعلى من قوة (عفريت) من الجن. فالحق هو القائل: {قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الجن...} [النمل: 39]. وهذا يدل على أن هناك أذكياء وأغبياء في عالم الجن أيضاً. وجاء الذي عنده علم من الكتاب فتسامى فوق عفريت الجن في الزمن، فقد قال هذا العفريت: {أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ...} [النمل: 39]. والمقام هو الفترة الزمنية التي قد يقعدها سليمان في مجلسه، فماذا قال الذي عنده علم من الكتاب- وهو إنسان-؟ {قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكتاب أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...} [النمل: 40]. كأنه سيأتي بعرش بلقيس قبل أن ينته سليمان من ردّ طرفه الذي أرسله ليبصر به شيئاً، إن سليمان رأى العرش بين يديه، ولذلك نجد عبارة القرآن معبرة: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ...} [النمل: 40]. كأن المسألة لا تتحمل. بل تم تنفيذها فوراً. إذن فالحق يوضح للمخلوقين من العناصر: إياكم أن تفهموا أن تميزكم بعناصركم، إنني أقدر بطلاقة قدرتي أن اجعل الأدنى يتحكم في الأعلى؛ لأنها إرادة من عَنْصَرَ العناصر. {قَالَ فاهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فاخرج إِنَّكَ مِنَ الصاغرين} [الأعراف: 13]. وكلمة {فاهبط} تشير على أن الهبوط أمر معنوي، أي أنك لست أهلاً لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة. هذا ما تدل عليه كلمة {فاهبط}، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالخروج من المكان. والصَّغَار هو الذل والهوان؛ لأنه قََابَل الأمر باستكبار، فلابد أن يجازى بالصَّغار. وبذلك يكون قد عومل بضد مقصده، والمعاملة بضد المقصد لون من التأديب والتهذيب والتعليم؛ مثلما يقرر الشرع أن الذي يقتل قتيلاً يحرم من ميراثه، لأنه قد قتله ليجعل الإرث منه، ولذلك شاء الله أن يحرمه من الميراث؛ فبارتكابه القتل صار محجوباً عن الميراث.  {قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14)} ومعنى {أَنظِرْنِي} أمهلني أي لا تمتني بسرعة، ولا تجعل أجلي قريباً، بدليل قوله سبحانه: {قَالَ إِنَّكَ مِنَ...}. فالإِنظار طلب الإِمهال، وعدم التعجيل بالموت، وقد طلبه إبليس لكي يشفي غليله من بني آدم وآدم؛ انه جاء له بالصَّغَار والذلة والطرد والهبوط، ولذلك أصر على أن يجتهد في أن يغري أولاد آدم ليكونوا عاصين أيضاً. وكأن إبليس في هذا الطلب أراد أن يُنْقذ من الموت وأن يبقى حيًّا إلى يوم البعث الذي يبعث فيه كل من مات. وكأنه يريد أن يقفز على قول الحق: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الموت...} [آل عمران: 185]. فأوضح الحق: أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم لك؛ لأن الأجل لو عرف فقد يعصي من يعلمه مدة طويلة ثم يقوم بالعمل الصالح قبل ميعاد الأجل، ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه في كل وقت. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: {إلى يَوْمِ الوقت المعلوم} [الحجر: 38]. والوقت المعلوم هو النفخة الأولى: {وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ} [الزمر: 68]. وكأن إبليس كان يريد أن يفر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية، لكن ربنا أوضح أنه باق إلى وقت معلوم، وآخر الوقت المعلوم هذا لابد أن يكون قبل النفخة الأولى. نداء الايمان يتبع  اثبت وجودك
..
|
|
|
|

|
|
|
#2 | |
|
مشرفة قسم القرآن
      
|
{قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15)} فالإِنظار طلب الإِمهال، وعدم التعجيل بالموت، وقد طلبه إبليس لكي يشفي غليله من بني آدم وآدم؛ انه جاء له بالصَّغَار والذلة والطرد والهبوط، ولذلك أصر على أن يجتهد في أن يغري أولاد آدم ليكونوا عاصين أيضاً. وكأن إبليس في هذا الطلب أراد أن يُنْقذ من الموت وأن يبقى حيًّا إلى يوم البعث الذي يبعث فيه كل من مات. وكأنه يريد أن يقفز على قول الحق: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الموت...} [آل عمران: 185]. فأوضح الحق: أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم لك؛ لأن الأجل لو عرف فقد يعصي من يعلمه مدة طويلة ثم يقوم بالعمل الصالح قبل ميعاد الأجل، ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه في كل وقت. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: {إلى يَوْمِ الوقت المعلوم} [الحجر: 38]. والوقت المعلوم هو النفخة الأولى: {وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ} [الزمر: 68]. وكأن إبليس كان يريد أن يفر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية، لكن ربنا أوضح أنه باق إلى وقت معلوم، وآخر الوقت المعلوم هذا لابد أن يكون قبل النفخة الأولى. {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16)} والإغواء. إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الَغّي وهو: الإهلاك، ويقول الحق سبحانه وتعالى: {... فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّاً} [مريم: 59]. وحين نقرأ {فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي} أي فبإغوائك يا الله لي سأفعل كذا وكذا، وبذلك يكون قد نسب الإغواء لله لكن هل يغوي ربنا أو يهدي؟. إن الله يهدي دلالة وتمكيناً، وسبق أن تكلمنا كثيراً عن هداية الدلالة ودلالة التمكين، وسبحانه خلق الشيطان مختاراً، ولم يخلقه مرغماً ومسخراً كالملائكة، ولأنه قد خلق مختاراً فقد أعطاه فرصة أن يطيع وأن يعصي، وكأن الشيطان بقوله هذا يتمنى لو أنه قد خلق مقهوراً. ويقول إن الله هو الذي أعطاه سبب العصيان. ولم يلتفت إلى أن الاختيار إنما هو فرصة لا للغواية فقط، ولكنه فرصة للهداية أيضاً. وأنت أيها الشيطان الذي اخترت الغواية. إذن فقول الشيطان: {فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي} إنما يريد به الشيطان: أن يدخل بمعصيته على الله، ونقول له: لا، إن ربنا لم يغو؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وإنما يهدي؛ لأن الله لو خلقه مرغماً مقهوراً ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا؛ فقد خلقه على هيئة (افعل) و(لا تفعل)، واختار هو ألاّ يفعل إلا المعصية. {قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم} [الأعراف: 16]. والمفهوم من العبارة أنهم بنو آدم، والقعود لون من ألوان حركة الجسم الفاعل؛ لأن المتحرك إما أن يكون قائماً، وإما أن يكون قاعداً، وإما أن يكون مضجعاً نائماً. وأريح الحالات أن يكون نائماً مضجعاً؛ لأن الجسم في هذه الحالة يكون مستريحاً بفعل الجاذبية الأرضية، وحين يكون الإنسان قاعداً تقاومه الجاذبية قليلاً، وحين يكون واقفاً فهو يحمل جسمه على قدميه، ولذلك نقول لمن وقف طويلاً على قدميه: (اقعد حتى ترتاح) ولو قعد وكان متعباً فيقال له: (مضجع قليلاً لترتاح). ولماذا اختار الشيطان أن يقول: {لأَقْعُدَنَّ}؟ حتى يكون مطمئناً، فقد يتعب من الوقفة، أيضاً وهو في حالة القعود يكون منتبها متيقظاً، والحق يقول: {واقعدوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ...} [التوبة: 5]. ولم يقل: (قفوا) حتى لا يرهق الناس أنفسهم بالوقوف الطويل، ولكن ساعة يواجهون الأمر فعليهم بالنهوض. والقعود أقرب إلى الوقوف، لأن الاضجع أقرب إلى التراخي والنوم، وقد اختار الشيطان الموقف الذي يحفظ له قوته، ويبقى له انتباهه: {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم}. ومادام الشيطان سيغوي، وسيضل الغير، فسيختار للغواية من يكون في طريق الهداية. إنما من غوى باختياره وضل بطبيعته فالشيطان قد استراح من ناحيته ولا يريده، وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدون في الطاعة؛ فالشاب الطائع الملتزم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة؛ لأن الشيطان يتلصص على دين الإنسان، فهو كاللص، واللص لا يحوم حول بيت خرب. إنما يحوم اللص حول بيت عامر بالخير. إننا نلاحظ هذه المسألة في كل الناس حينما يأتون للصلاة فيقول الواحد منهم: حينما أصلي يأتي له الوسواس، ويشككني في الصلاة، نقول له: نعم هذا صحيح، وحين يأتي لك هذا الوسواس فاعتبره ظاهرة صحية في الإيمان؛ لأن معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول، ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة؛ لأنك لو كنت فاسداً من البداية، ووقفت للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس. لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله: {وَإِماَّ يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله...} [الأعراف: 200]. لماذا؟. لأن الله خلقك وخلقه، وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجري منك مجري الدم في العروق وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها؛ ويأتي إليك بمهام الأشياء في وقت الصلاة؛ فتتذكر الأشياء التي لم تكن تتذكرها، ويأتي لك بأعقد المسائل وأنت تصلي؛ وكل ذلك لأنه قال: {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم}، ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف، ولن يجلس الشيطان في مجلس خمر، لكنه يقعد على أبواب المساجد أو في المساجد ليفسد للناس أعمالهم الصالحة. فماذا نفعل في هذه الحال؟. يدلنا الحق سبحانه أن نستعيذ: {وَإِماَّ يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله} فمعنى {فاستعذ} أي فالتجئ منه إلى الله؛ لإن الله الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك، وفي دمك، وفي خواطرك، هو القادرعلى منعه، وحين تقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بفزع والتجاء إليه- سبحانه- فإنه- جل شأنه- ينقذك منه. وإن كنت تقرأ القرآن ثم جاء لك الخاطر من الشيطان فقل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أنك أدركت من أين جاءت هذه النزغة: مرة واثنتين وثلاثاً، فيقول الشيطان لنفسه: إن هذا المؤمن حاذق فطن وحذر لا أستطيع غوايته، ولأبحث عن غيره. ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة، وقد شهرَ عنه الفتيا، وذهب إليه سائل يقول: ضاع مني مال في أرض كنت قد دفنته فيها، ولا أعرف الآن مكانه. دلني عليه أيها الشيخ؟. وبطبيعة الحال كان هذا السؤال في غير العلم، فقال أبو حنيفة: يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، ولكني احتال لك؛ إذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليلة، لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جنداً من جنوده يقول لك عن مكان مالك. وبينما أبو حنيفة يؤدي صلاة الفجر، وإذا بالرجل يقبل ضاحكاً مبتسماً قائلا: يا إمام لقد وجدت المال، فضحك أبو حنيفة، وقال: والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسيأتي ليُخبرك، فهلاّ أتممتها شكراً لله، هيا قم إلى الصلاة. إذن فقد عرف الشيطان كيف يقعد: وكيف يقسم، لأنه في آية أخرى يقول: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 82]. لقد استطاع أن يأتي بالقسم الذي يعينه على مهمته؛ فقال: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ} أي بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم فأنت الغالب الذي لا يقهر؛ لأنك إن أردتهم ما استطعتُ أن آخذهم، لكنك شئت لكل إنسان أن يختار: {فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. فأقسم، ومن هذا الباب يدخل الشيطان على الإِنسان: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}. واستدرك على نفسه أيضاً وقال: {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} [ص: 83]. لأن الذي يريده الله مهديًّا لا يستطيع الشيطان أن يغويه؛ لأنه لا يناهض ربنا ولا يقاومه، إنما يناهض خلق الله، ولا يدخل مع ربنا في معركة، إنما يدخل مع خلقه في معركة ليس له فيه حجة ولا قوة؛ لأن الذي يغلب في المعارك إما أن يرغمك على الفعل، وإما أن يقنعك لتفعل أنت بدون إرغام. وهل يملك إبليس واحدة من هذه؟. لا، ولذلك سيأتي في الآخرة يقول: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم لِي...} [إبراهيم: 22]. والسلطان قسمان: سلطان يقهر، وسلطان يقنع. والشيطان يدخل على الإِنسان من هذه الأبواب. {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)} فالذي بين اليد هو ما كان إلى الإمام، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} أي من الوراء، {وعَنْ أَيْمَانِهِمْ} أي من جهة اليمين، {وعَن شَمَآئِلِهِمْ} أي من جهة اليسار. والشيء الذي أمام العالم كله، ونسير إليه جميعاً هو {الدار الآخرة} وحين يأتي الشيطان من الأمام فهو يشككهم في حكاية الآخرة ويشككهم في البعث. ويحاول أن يجعل الإِنسان غير مقبل على منهج الله، فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله، ويشكّون في وجود دار أخرى سيُجَازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القرآن بلسان حاله: {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَآؤُنَا الأولون} [الصافات: 16-17]. ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجعل للشيطان منفذاً فيها، فيوضح لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولاً؛ لذلك لن يعجز عن إعادتنا، والإِعادة بالتأكيد أهون من البداية؛ لأنّه سيعيدهم من موجود، لكن البداية كانت من عدم، إنه- سبحانه- عندما يبيّن للناس أن الإِعادة أهون من البداية فهو يخاطبهم بما لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره، وإلاّ فالله- جل شأنه- تستوي لدى طلاقة قدرته كل الأعمال فليس لديه شيء سهل وهيّن وآخر صعب وشاق ويبلغنا- سبحانه- بتمام إحاطة علمه فيقول: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} [ق: 4]. أي أن لكل واحدٍ كتاباً مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه. والشيطان- أيضاً- يأتي من الخلف، وخلف كل واحد منا ذريته، يخاف ضيعتهم، فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء مستقبل الأبناء، وفساد أناس كثيرين يأتي من هذه الناحية، ومثل هذا الفساد يأتي حين يبلغ بعض الناس منصبًّا كبيراً، وقد كبرت سنّه، ويقبل على الله بشرّ، ويظن أنه يترك عياله بخير. لكن إن كنت تخاف عليهم حقًّا فأمِّن عليهم في يد ربهم، ولا تؤمِّن حياتهم في جهة ثانية. {وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ الله وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} [النساء: 9]. ولماذا لم يأت الشيطان للإِنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هي الجهة التي يلجأ إليها مستغيثا ومستجيرا بربه، والتحتية هي جهة العبودية الخاصة. فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فهو في هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}. ويقول تعالى: {ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17]. ويأتي الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة. واليمين رمز العمل الحسن؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين، وكاتب السيئات على الشمال، ويأتي عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية. ونلحظ أن الحق استخدم لفظ {عَنْ أَيْمَانِهِمْ} و{عَن شَمَآئِلِهِمْ} ولم يأت ب (على) لأن (على) فيها استعلاء، والشيطان ليس له استعلاء أبداً؛ لأنه لا يملك قوة القهر فيمنع، ولا قوة الحجة فيقنع. ولأن أكثر الناس لا تتذكر شكر المنعم عليهم، فيجيد الشيطان غوايتهم. ولذلك يقول الحق تذييلاً للآية: {... وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17]. {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18)} لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيّل أنه ذكي، فشرح لنا خطته ومنهجه فدلل لنا على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفاً، فسبحانه القائل: {... إِنَّ كَيْدَ الشيطان كَانَ ضَعِيفاً} [النساء: 76]. لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره، والناصح هو من يحتاط، ويأخذ المناعة ضد النزغ الشيطاني. وهنا يقول الحق: {قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً...} [الأعراف: 18]. وقال له الحق من قبل: {قَالَ فاهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فاخرج إِنَّكَ مِنَ الصاغرين} [الأعراف: 13]. إذن فهناك هبوط وخروج بصَغار ومجاوزة المكان، ثم هنا أيضاً تأكيد بأنه في حالة الخروج سيكون مصاحباً للذم والصغار والطرد واللعن. ويقول الحق سبحانه: {... لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأعراف: 18]. وفي هذا اخبار لمن يتبعون الشيطان بأنهم أهل لجهنم، ولم يعدَّها سبحانه لتسع الكافرين فقط، لكنه أعدّها على أساس أن كل الخلق قد يكفرون به سبحانه، كما أعدّ الجنة على أساس أن الخلق جميعاً يؤمنون به؛ فليس عنده ضيق مكان، وإن آمن الخلق جميعاً؛ فإنه- جل شأنه- قد أعد الجنة لاستقبالهم جميعاً، وإن كفروا جميعاً فقد أعدّ النار لهم جميعاً؛ تأكيداً لقوله الحق: {أولئك هُمُ الوارثون الذين يَرِثُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون: 10-11]. وقوله الحق: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [الأنبياء: 98]. وبهذا نكون قد شرحنا مسألة إبليس الذي امتنع عن طاعة أمر الآمر الأعلى بالسجود لآدم. نداء الايمان  |
|
|
|

|
|
|
#3 | |
|
مشرفة قسم القرآن
      
|
|
|
|
|

|
|
|
#4 | |
|
مشرفة قسم القرآن
      
|
{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} وكلمة {يابني ءَادَمَ} لفت إلى أن تتذكروا ماضي أبيكم مع عدوكم المبين، إبليس، أنتم أولاد آدم، والشيطان موجود، فانتبهوا. لقد أنزل الحق عليكم لباسا يواري سوءاتكم؛ لأن أول مخالفة حدثت كشفت السوءة، والإنزال يقتضي جهة علو لنفهم أن كل خير في الأرض يهبط مدده من السماء، وسبحانه هو من أنزل اللباس لأنه هو الذي أنزل المطر، والمطر روى بذور النبات فخرجت النباتات التي غزلناها فصارت ملابس، وكأنك لو نسبت كل خير لوجدته هابطا من السماء. ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على عباده فيقول: {وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ...} [الزمر: 6]. نعم هو الذي أنزل من الأنعام أيضاً لأن السببية في النبات من مرحلة أولى، والسببية في الحيوان من مرحلة ثانية، فهو الذي جعل النبات يخرج من الأرض ليتغذى عليه الحيوان، ويقول سبحانه أيضاً: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...} [الحديد: 25]. نعم فسبحانه هو من أنزل الحديد أيضاً؛ لأننا نأخذه من الأرض التي خلقها الله، وهذا دليل على أن التنزيلات إنما أراد الله أن يحمي بها كل منهج. {يابني ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ...} [الأعراف: 26]. فإذا كنا قد أنزلنا اللباس يواري سوءات الحس وسوءات المادة، كذلك أنزلنا اللباس الذي يواري سوءات القيم. فكلما أنكم تحسّون وتدركون أن اللباس المادي يداري ويواري السوءة المادية الحسية فيجب أن تعلموا أيضاً أن اللباس الذي ينزله الله من القيم إنما يواري ويستر به سواءتكم المعنوية. ولباس الحياة المادية لم يقف عند موارة السوءات فقط، بل تعدى ذلك إلى ترف الحياة أيضاً. لذلك قال الحق: {... قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التقوى ذلك خَيْرٌ ذلك مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]. والريش كساء الطير، وقديماً كانوا يأخذون ريش الطير ليزينوا به الملابس. وكانوا يضعون الريش على التيجان، وأخذ العوام هذه الكلمة وقالوا: فلان مريش أي لا يملك مقومات الحياة فقط، بل عنده ترف الحياة أيضاً، فكأن هذا القول الكريم قد جاء بمشروعية الترف شريطة أن يكون ذلك في حل. وقيل أن يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال في الحياة، فقال سبحانه: {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً...} [النحل: 8]. والركوب لتجنب المشقة، والزينة من أجل الجَمَال. وكذلك يقول الحق سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرزق...} [الأعراف: 32]. بل سبحانه طلب زينتنا في اللقاء له في بيته فيقول: {يابني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...} [الأعراف: 31]. إذن فهذا أمر بالزينة، وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه: {وَرِيشاً وَلِبَاسُ التقوى ذلك خَيْرٌ...} [الأعراف: 26]. نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله؛ لأن اللباس المادي يستر العورة المادية، وقصاراه أن يكون فيه مواراة وستر لفضوح الدنيا، لكن لباس التقوى يواري عنا فضوح الآخرة. أو لباس التقوى هو الذي تتقون به أهوال الحروب؛ إنّه خير من لباس الزينة والرياش لأنكم تحمون به أنفسكم من القتل، أو ذلك اللباس- لباس التقوى- خير من اللباس المادي وهو من آيات الله، أي من عجائبه، وهو من الأشياء اللافتة؛ فالإِنسان منكم مكون من مادة لها احتياجات مادية وعورات مادية، وهناك أمور قيمية لا تنتظم الحياة إلا بها، وقد أعطاك الحق مقومات الحياة المادية، وزينة الحياة المادية، وأعطاك ما تحيا به في السلم والحرب، ومنهج التقوى يحقق لك كل هذه المزايا. فخذ الآيات مما تعلم ومما تحس لتستنبط منها ما يغيب عنك مما لا تحس. {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)} قبل أن يطلب منا سبحانه ألا نفتتن بالشيطان، أوضح أنه قد رتب لنا كل مقومات الحياة، وعلينا أن نتذكر موقف الشيطان، من أبينا آدم وإِغواءه له. والفتنة في الأصل هي الاختبار، وتُطلق- أحياناً- على الأثر السيء حيث تكون أشد من القتل، لكن هل يسقط الإِنسان في كل فتنة؟ لا؛ لأن الفتنة هي الاختبار، وفي الاختبار إما أن ينجح الإِنسان، وإمّا أن يرسب، فإن نجح أعطته الفتنة خيراً وإن رسب تعطه شرًّا. وبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى قصة خلق آدم، وأعلمنا أنه خلقه للخلافة في الأرض، وأن موضوع الجنة هو حلقة مقدمة لتلقي الخلافة؛ لأنه إذا ما أصبح خليفة في الأرض؛ فلله منهج يحكمه في كل حركاته، ومادام له منهج يحكمه في كل حركاته فرحمة به لم ينزل الله للأرض ابتداءً ليتلقى المنهج بدون تدريب واقعي على المنهج، فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف في الأرض، وحذره من الشيطان الذي أبى أن يسجد له، وأراد منه أن يأخذ التجربة في التكليف. وكل تكليف محصور في (افعل كذا) و(لا تفعل كذا)؛ لذلك شاء الله أن يجعل له في الجنة فترة تدريب على المهمة؛ لينزل إلى الأرض مباشراً مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية، وأوضح له: أَنْ كُلْ مِنْ كُلِّ ما في الجنة، ولكن لا تقرب هذه الشجرة. و(كُلْ) أَمْرٌ، و(ولا تقرب) نَهْيٌّ. وكل تكليف شرعي هو بين (لا تفعل) وبين (افعل). وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يضع ويجعل له العقبات في تنفيذ منهج الله، فلما قرب آدم وحواء وأكلا منها؛ خالفا أمر الله في {وَلاَ تَقْرَبَا}، وأراد الله أن يبين لهما بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لابد أن ينشأ عنها عورة تظهر في الحياة، فبدت له ولزوجته سواءتهما، فلما بدت لهما سواءتهما علم كل منهما أن مخالفة أمر الله تُظهر عورات الأرض وعورات المجتمع، فأمره الله: أن اهبط إلى الأرض مزوداً بهذه التجربة. ولما هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة، وأراد أن يبين لنا أنه عصى أمر ربه في قوله: {وَلاَ تَقْرَبَا}، وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وأراد سبحانه أن يبين لنا أن آدم يتمثل فيه أنه بشر يصيب ويخطئ، وتدركه الغفلة، وقد يخالف منهج الله في شيء، ثم يستيقظ من غفلته فيتوب، وبعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله وصار نبيًّا؛ جاءت له العصمة فلا يغفل ولا ينسى في تبليغ الرسالة. ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآني: {... وعصى ءَادَمُ رَبَّهُ فغوى} [طه: 121]. إنّ هذه طبيعة البشر أن يعصي ثم يتوب إذا أراد التوبة، ولابد أن نفطن أيضاً إلى قوله الحق: {ثُمَّ اجتباه رَبُّهُ} إذن فالاصطفاء جاء بعد المعصية؛ لأن عصيانه كان أمراً طبيعيًّا لأنه بشر، يخطئ ويصيب، ويسهو ويغفل. ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيًّا ورسولاً، ومادام قد صار نبيًّا ورسولاً فالعصمة تأتي له: {ثُمَّ اجتباه رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وهدى} [طه: 122] إذن لا يصح لنا أن نقول: كيف يعصي آدم وهو نبي؟! نقول: تنبه إلى أن النبوة لم تأته إلا بعد أن عصى وتاب؛ فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية كلها، والبشرية منقسمة إلى قسمين: بشر مبلغون عن الله، وأنبياء يبلغون عن الله، فله في البشرية أنه عصى، وله في النبوة أن ربه قد اجتباه فتاب عليه وهداه. والذين يقولون: إن آدم كان مخلوقاً للجنة، نقول لهم: لا. افهموا عن الله، لأنه يقول: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةً}. إن أمر الجنة كان مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الأرض. إنها كانت تدريباً على المهمة التي سيقوم بها في الأرض، والا فلو أن آدم قد خلقه الله للجنة وأن المعصية أخرجته، إلا أن الله قد قبل منه توبته، وما دام قبل توبته فكان يجب أن يبقيه في الجنة، ومن هنا نقول ونؤكد أن الجنة كانت مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الأرض. وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها، وأن نعرف عداوة الشيطان لنا، وألا نقع في الفتنة كما وقع آدم. {يابني ءَادَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الجنة يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَآ...} [الأعراف: 27]. وهذا نهي لبني آدم وليس نهيا للشيطان، وهذا في مُكنة الإنسان أن يفعل أو لا يفعل، فسبحانه لا ينهى الإنسان عن شيء ليس في مكنته، بل ينهاه عما في مكنته، والشيطان قد أقسم أن يفتنه وسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}. فإياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان؛ لأن أمره مع أبيكم واضح، ويجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم فلا يفتننكم كما أخرج أبويكم من الجنة، ويتساءل البعض: لماذا لم يقل الله: لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم، وقال: {لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الجنة}؟. ونقول هذا هو السمو والافتنان الراقي في الأداء البياني للقرآن. وإن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يخرجنا من جنة التكليف. كما فتن أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة. ويقال عن هذا الأسلوب إنه أسلوب احتباك، وهو أن تجعل الكلام شطرين وتحذف من كل منهما نظير ما أثبت في الآخر قصد الاختصار. وهذا هو الأسلوب الذي يؤدي المعنى بمنتهى الإيجاز؛ لينبه ذهن السامع لكلام الله. فيلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء، وعدم الفضول في الأساليب. {لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الجنة...} [الأعراف: 27]. والفتنة- كما علمنا- هي في الأصل الاختبار حتى ننقي الشيء من الشوائب التي تختلط به، فإذا كانت الشوائب في ذهب فنحن نعلم أن الذهب مخلوط بنحاس أو بمعدن آخر، وحين نريد أن نأخذ الذهب خالصاً نفتنه على النار حتى ينفض ويزيل عنه ما علق به. كذلك الفتنة بالنسبة للناس، إنها تأتي اختباراً للإنسان لينقي نفسه من شوائب هذه المسألة، وليتذكر ما صنع إبليس بآدم وحواء. فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن؛ لأن الفتنة ستضرك كما سبق أن الحقت الضرر بأبيك آدم وأمك حواء. والشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن، والجن جنس منه المؤمن ومنه الكافر. فقد قال الحق سبحانه: {وَأَنَّا مِنَّا الصالحون وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ...} [الجن: 11]. والشيطان المتمرد من هذا الجنس على منهج الله ليس واحداً، واقرأ قول الحق سبحانه: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ...} [الكهف: 50]. وهنا يقول الحق سبحانه: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ...} [الأعراف: 27]. و(قبيله) هم جنوده وذريته الذين ينشرهم في الكون ليحقق قَسَمَه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 82]. إذن ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله، وحينما عصى إبليس ربّه عزّ عليه ذلك، فبعد أن كان في قمة الطاعة صار عاصيًّا لأمر الله معصية أَدَّته وأوصلته إلى الكفر؛ لأنه ردّ الحكم على الله. إن ذلك قد أوغر صدره وأحنقه، وجعله يوغل ويسرف في عداوة الإِنسان لأنه عرف أن طرده ولعنه كان بسبب آدم وذريته . {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ...} [الأعراف: 27]. وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان، فلو كان المراد شياطين الإِنس معهم لما قال: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ}. وعلى ذلك فهذه الآية خاصة بالذرية، ويعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه إلى أن الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالذرية بل سيزين لقوم من البشر أن يكونوا شياطين الإِنس كما وُجد شياطين الجن، وهم من قال فيهم سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرُفَ القول غُرُوراً...} [الأنعام: 112]. وكلمة {زُخْرُفَ القول} تعني الاستمالة التي تجعل الإِنسان يرتكب المعصية وينفعل لها، ويتأثر بزخارف القول. وكل معصية في الكون هكذا تبدأ من زخرف القول، فللباطل دعاته، ومروجوه، ومعلنوه، إنهم يزينون للإِنسان بعض شهواته التي تصرفه عن منهج الله، ونلاحظ أن أعداء الله، وأعداء منهج الله يترصدون مواسم الإِيمان في البشر، فإذا ما جاء موسم الإِيمان خاف أعداء الله أن يمر الموسم تاركاً هبة في نفوس الناس، فيحاولوا أن يكتلوا جهودهم حتى يحرموا الناس نفحة الموسم، فإذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم فقد حققوا غرضهم في العداوة للإِسلام. {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ}. إن الشيطان يراكم أيها المكلفون هو وقبيله. والقبيل تدل على جماعة أقلها ثلاثة من أجناس مختلفة أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة. واختلف العلماء حول المراد من هذا القول الكريم؛ فقال قوم: (إنهم جنوده وذريته). ويقصدون جنوده من البشر، ولم يلتفتوا إلى قول الحق: {مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} فلابد أن يكون المراد بالقبيل هنا الذرية؛ لأننا نرى البشر، وفي قوله الحق تغليظ لشدة الحذر والتنبه؛ لأن العدو الذي تراه تستطيع أن تدفع ضرره، ولكن العدو الذي يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيده أشد، والجن يرانا ولا نراه، وبعض من العلماء علل ذلك لأننا مخلوقون من طين وهو كثيف، وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة. فالشفيف يستطيع أن يؤثر في الكثيف، بدليل أننا نحس حرارة النار وبيننا وبينها جدار، ولكن الكثيف لا يستطيع أن يؤثر في الشفيف ولا ينفذ منه. إذن فنفوذ الجن وشفافيته أكثر من شفافية الإِنسان، ولذلك أخذ خفة حركته. ونحن لا نراه. إذن معنى ذلك أن الشيطان لا يُرى، ولكن إذا كان ثبت في الآثار الصحيحة أن الشيطان قد رُئى وهو من نار، والملائكة من نور، والاثنان كل منهما جنس خفي مستور، وقد تشكل المَلك بهيئة إنسان، وجاء لرسول الله وقال لنا صلى الله عليه وسلم: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». وعلى ذلك رأى السابقون المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لا على صورة ملائكيّته، ولكن على صورة تتسق مع جنس البشر، فيتمثل لهم مادة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان وقال: (إن عفريتا من الجن جعل يفتك عليّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة، وإن الله أمكنني منه فَذَعَتّهُ فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوراي المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون). وذلك من أدب النبوة. إذن فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حقيقته، فإذا ما أرادك أن تراه.. فهو يظهر على صورة مادية. وقد ناقش العلماء هذا الأمر نقاشاً يدل على حرصهم على فهم كتاب الله، ويدل على حرصهم على تجلية مراداته وأسراره، فقال بعضهم: حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لابد أن نقول: إننا لن نراه. وأقول: إن الإنسان إن رأى الجني فلن يراه على صورته، بل على صورة مادية يتشكل بها، وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان؛ لأن الجني لو تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر يمكن أن يراه الإنسان، وحينئذ لفقدنا الوثوق بشخص من نراه، هل هو الشيء الذي نعرفه أو هو شيطان قد تمثل به؟ إن الوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة، وحركة المجتمع؛ لأنك لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليك، ولا تثق في صديقك إلا إذا عرفت أنه صديقك. ولا تأخذ علماً إلا من عالم تثق به. وهب أن الشيطان يتمثل بصورة شخص تعرفه، وهنا سيشكك هذا الشيطان ويمنع عنك الوثوق بالشخص الذي يتمثل في صورته. وأيضاً أعدى أعداء الشيطان هم الذين يبصرون بمنهج الله وهم العلماء، فما الذي يمنع أن يتشكل الشيطان بصورة عالم موثوق في علمه، ثم يقول كلاماً مناقضاً لمنهج الله؟. إذن فالشيطان لا يتمثل، هكذا قال بعض العلماء، ونقول لهم: أنتم فهمتم أن الشيطان حين يتمثل، يتمثل تمثلاً استمرارياً، لا. هو يتمثل تمثل الومضة؛ لأن الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو لصورة مادية لحكمته الصورة التي انتقل إليها، وإذا حكمته الصورة التي انتقل إليها فقد يقتله من يملك سلاحاً، إنه يخاف منا أكثر مما نخاف منه، ويخاف أن يظهر ظهوراً استمرارياً؛ لذلك يختار التمثل كومضة، ثم يختفي، والإنسان إذا تأمل الجني المشكل. سيجد فيه شيئاً مخالفاً، كأن يتمثل- مثلا- في هيئة رجل له ساق عنزة لتلتفت إليه كومضة ويختفي؛ أنه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التي يتشكل بها تحكمه. وإذا عرفت ذلك أمكنك أن تصرعه. ويتابع الحق سبحانه: {... إِنَّا جَعَلْنَا الشياطين أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 27]. والشياطين من جَعْل الله، وسبحانه خلّى بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنوهم والا لو أراد الله منعهم من أن يفتنوهم. لفعل.. إذن فكل شيء في الوجود، أو كل حدث في الوجود يحتاج إلى أمرين: طاقة تفعل الفعل، وداع لفعل الفعل. فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل، والداعي إلى الفعل، فإبراز الفعل في الصورة النهائية نستمدها من عطاء الله من الطاقة التي منحها الله للإنسان. فأنت تقول: العامل النساج نسج قطعة من القماش في غاية الدقة، ونقول: إن العامل لم ينسج، وإنما الآلة، والآلة لم تنسج، لكن الصانع الذي صنعها أرادها كذلك، والصانع لم يصممها الا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركة بها. إذن فالعامل قد وجّه الطاقة المخلوقة للمهندس في أن تعمل، واعتمد على طاقة المهندس الذي صنعها في المصنع، والمهندس اعتمد على طاقة الابتكار وعلى العالم الذي ابتكر قانون الحركة، والعالم قد ابتكرها بعقل خلقه الله، وفي مادة خلقها الله. إذن فكل شيء يعود إلى الله فعلاً؛ لأنه خالق الطاقة، وخالق من يستعمل الطاقة، والإنسان يوجه الطاقة فقط، فإذا قلت: العامل نسج يصح قولك، وإذا قلت: الآلة نسجت، صح قولك، وإذا قلت: إن المصنع هو الذي نسج صح قولك. إذن فالمسألة كلها مردها في الفعل إلى الله، وأنت وجهت الطاقة المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل أمر من الأمور. فإذا قال الله {إِنَّا جَعَلْنَا الشياطين} أي خلّينا بينهم وبينهم المفتونين بهم، غير أننا لو أردنا الا يفتنوا أحداً لما فتنوه. وهذا ما فهمه إبليس. {... لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} [ص: 82-83]. إذن من يريده الله معصوماً لا يستطيع الشيطان أن يغويه، وتعلم الشياطين أن الله خلّى بينهم في الاختيار، هذه اسمها تخلية؛ ولذلك لا معركة بين العلماء. فمنهجهم أن الطاقة مخلوقة لله، ونسب كل فعل إلى الله، ومنهم من رأى أنَّ موجّه الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشر، ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله في أنه الفاعل لكل شيء، ومنهم من قال: إن الإنسان هو الذي فعل المعصية.. أي أنه وجه الطاقة إلى عمل والطاقة صالحة له، فربنا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل الضار ولا خلاف بينهم جميعاً. {... إِنَّا جَعَلْنَا الشياطين أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 27]. إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن، ولكن الذي آمن لا يتخذه الشيطان وليًا. {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28)} والفاحشة مأخوذة من التفحش أي التزايد في القبح، ولذلك صرفها بعض العلماء إلى لون خاص من الذنوب، وهو الزنا، لأن هذا تزيد في القبح، فكل معصية يرتكبها الإنسان تنتهي بأثرها، لكن الزنا يخلف آثاراً.. فإمّا أن يوأد المولود، وإما أن تجهض المرأة، وإما أن تلد طفلها وتلقيه بعيداً، ويعيش طريداً في المجتمع لا يجد مسئولاً عنه، وهكذا تصبح المسألة ممتدة امتداداً أكثر من أي معصية أخرى. وتصنع هذه المعصية الشك في المجتمع. ولنا أن نتصور إن إنساناً يشك في أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه، وهذه بلوى كبيرة للغاية. والذين قالوا: إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]. أو الفاحشة هي ما فيه حد، أو الفاحشة هي الكبائر، ونحن نأخذها على أنها التزيد في القبح على أي لون من الألوان. فما هي الفاحشة المقصودة هنا؟. إنها الفواحش التي تقدمت في قوله: {مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ...} [المائدة: 103]. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: {وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ...} [الأنعام: 137]. وكذلك في قوله الحق سبحانه: {وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الحرث والأنعام نَصِيباً فَقَالُواْ هذا للَّهِ بِزَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكَآئِنَا...} [الأنعام: 136]. أو أن المقصود أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فيطوف الرجال نهاراً، والنساء يطفن ليلاً، لماذا؟. لأنهم ادَّعَوْا الورع. وقالوا: نريد أن نطوف إلى بيت ربنا كما ولدتنا أمهاتنا، وأن نتجرد من متاع الدنيا، ولا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله فيها. وقولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا} تقليد، والتقليد لا يعطي حكماً تكليفياً، وإن أعطى علماً تدريبيا، بأن ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا ويألفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف. ومما يدل على أن التقليد لا يعطي حقيقة، أنك تجد المذهبين المتناقضين- الشيوعية والرأسمالية مثلاً- مقلدين؛ لهذا المذهب مقلدون، ولهذا المذهب مقلدون. فلو أن التقليد معترف به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة، والمتضادان لا يصبحان حقيقة؛ لأنهم- كما يقولون- الضدان لا يجتمعان، هذا هو الدليل العقلي في إبطال التقليد. ولذلك نلاحظ في أسلوب الأداء القرآني أنه أداء دقيق جداً؛ فالذي يتكلم إله. {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا والله أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: 28]. والرد من الله عليهم أنه سبحانه لم يأت في مسألة التقليد بردّ لأنه بداهة لا يؤدي إلى حقيقة، بل قال: {... قُلْ إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بالفحشآء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]. وهذا رد على قولهم: والله أمرنا بها. وأين الرد على قولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا}؟. نقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد؛ لأنه أمر يرفضه العقل الفطري، ولذلك ترك الله الرد عليه؛ لوضوح بطلانه عند العقل الفطري، وجاء بالرد على ادعائهم أن الله يأمر بالفحشاء، فالله لا يأمر بالفحشاء. ثم كيف كان أمر الله لكم؟. أهو أمر مباشر.. بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب فاحشة؟ ألم تنتبهوا إلى قول الحق سبحانه: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً...} [الشورى: 51]. أم بلغكم الأمر بالفاحشة عن طريق نبي فكيف ذلك وأنتم تكذبون مجيء الرسول؟. وهكذا يكون قولكم مردوداً من جهتين: الجهة الأولى: إنه لا طريق إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل؛ لأنكم لستم أهلاً للخطاب المباشر، والجهة الثانية: أنكم تنكرون مسألة الأنبياء والرسل. فأنتم لم يخاطبكم الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن يقال لكم: {... أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]. ولا جواب على السؤال إلا بأمرين: إما أن يقولوا: (لا) فقد كذبوا أنفسهم، وإما أن يقولوا: (نعم)؛ فإذا قالوا: نعم نقول على الله ما لا نعلم؛ فقد فضحوا أنفسهم وأقروا بأن الله لم يأمر بالفاحشة، بل أمر الله بالقسط،  {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29)} والقسط هو العدل من قسط قِسطاً، وأمّا قاسط فهي اسم فاعل من قسط قَسْطاً وقَسُوطاً أي جار وعدل عن الحق، والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق والظالمون، كلمة العدل هي التسوية، فإن ملت إلى الحق، فذلك العدل المحبوب. وإن ملت إلى الباطل، فذلك أكره مكروه {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقسط}. وهذه جملة خبرية. {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 29]. وهذا فعل أمر، وقد يتبادر إلى الذهن إن هذا من عطف الأمر على الخبر، ولكن لنلتفت أن الحق يعطفها على (قل)، فكأن المقصود هو أن يقول: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقسط وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. والوجه هو السمة المعينة للشخص؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعرفه إلا أن كان له لباس مميز لا يرتديه الا هو. والوجه أشرف شيء في التكوين الجسمي، ولذلك كان السجود هو وضع الوجه في الأرض، وهذا منتهى الخضوع لأمر الله بالسجود؛ لأن السجود من الفاعل المختار وهو الإنسان يكون بوضع الجبهة على الأرض. وكل شيء خاضع لحكم الله نقول عنه: إنه ساجد. {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب...} [الحج: 18]. والشجر يسجد وهو نبات، والدواب تسجد وهي من جنس الحيوان، والشمس والقمر والنجوم والجبال من الجماد وهي أيضا ساجدة، لكن حين جاء الحديث عن الإنسان قسمها سبحانه وقال: {وَكَثِيرٌ مِّنَ الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب...} [الحج: 18]. لأن الإنسان له خاصية الاختيار، وبقية الكائنات ليس له اختيار. إذن فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الخضوع، أما الإنسان فالسجود يكون بالوجه ليعرف أنه مستخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطائعة وكلها تسبح ربنا، فإذا كان السيد الذي تخدمه كل هذه الأجناس حيواناً، ونباتاً، وجماداً قد وضع وجهه على الأرض فهو خاضع من أول الأمر حين نقول عنه إنه ساجد. {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...} [الأعراف: 29]. والإقامة أن تضع الشيء فيما هيئ له وخُلق وطُلب منه، وإن وجهته لناحية ثانية تكون قد ثنيته وأملته وحنيته، وعَوِّجته. إذن فإقامة الوجه تكون بالسجود؛ لأن الذي سخر لك هذا الوجود وحكمك بمنهج التكليف هو من جعلت وجهك في الأرض من أجله، وإن لم تفعل فأنت تختار الاعوجاج لوجهك، واعلم أن هذا الخضوع والخشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة على الأجناس الأخرى التي تعطيك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة في العمل ويعطيك خير الآخرة أيضاً. والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على الأجناس فيتقن العبودية لله، فيأخذ خيري الدنيا والآخرة حيث لا يفوته فيها النعيم ولا يفوت هو النعيم، أما في الدنيا فأنت تقبل عليها باستخلاف وتعلم أنك قد يفوتك النعيم، أو تفوت أنت النعيم، وحين تتذكر الله وتكون خاضعاً لله فأنت تنال البركة في حركة الاستخلاف. {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...} [الأعراف: 29]. والمسجد مكان السجود، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». إذن فكل موضع في الأرض مسجد؛ فإن دخلت معبداً لتصلي فهذا مسجد. والأرض كلها مسجد لك. يصح أن تسجد وتصلي فيها. وتزاول فيها عملك أيضا، ففي المصنع تزاول صنعتك فيه، وحين يأتي وقت الصلاة تصلي، وكذلك الحقل تصلي فيه، لكن المسجد الاصطلاحي هو المكان الذي حُبس على المسجدية وقصر عليها، ولا يزاول فيه شيء آخر. فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد كلها تكن {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ} في جميع أنحاء الأرض. وإن أخذتها على المسجد، فالمقصود إقامة الصلاة في المكان المخصوص، وله متجه وهو الكعبة. وكذلك يكون اتجاهك وأنت تصلي في أي مكان. والمساجد نسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله، فبعضنا يبني مسجداً هنا أو هناك. ويتجهون إلى بيت باختيار الله وهو الكعبة. ولذلك كانت كعبة ومتوجهاً لجميع بيوت الله. وقصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه عليها، أي على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة. وهو أن تتجهوا وأنتم في صلاتكم إلى الكعبة فهي بيت الله باختيار الله. وساعة ما تصادفك الصلاة صل في أي مسجد، أو {أَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد، وهنا اختلف العلماء، هل أداء الصلاة وإقامتها في المسجد ندباً أو حتماً؟. والأكثرية منهم قالوا ندباً، والأقلية قالوا حتماً. ونقول: الحتمية لا دليل عليها. من قال بحتمية الصلاة في المسجد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسِ بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم». ونقول: هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يفعل؟ لم يفعل رسول الله ذلك، إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة في المساجد عند أي أذان للصلاة. ويقول الحق سبحانه: {وادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدين...} [الأعراف: 29]. والدعاء: طلب من عاجز يتجه به لقادر في فعل يحبه الداعي. وحين تدعو ربك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب؛ لأن الأسباب إن كانت في بالك فأنت لم تخلص الدين، لأن معنى الإِخلاص هو تصفية أي شيء من الشوائب التي فيه، والشوائب في العقائد وفي الأعمال تفسد الإِتقان والإِخلاص، وإياكم أن تفهموا أن أحداً لا تأتي له هذه المسألة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنّي لَيُغَانُ على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة». إذن فالإِخلاص عملية قلبية، وأنت حين تدعوا الله ادعه دائماً عن اضطرار، ومعنى اضطرار. أن ينقطع رجاؤك وأملك بالأسباب كلها. فذهبت للمسبب، وما دمت مضطراً سيجيب ربنا دعوتك؛ لأنك استنفدت الأسباب، وبعض الناس يدعون الله عن ترف، فالإِنسان قد يملك طعام يومه ويقول: ارزقني، ويكون له سكن طيب ويقول: أريد بيتاً أملكه. إذن فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها أسباب، فيجب أن نأخذ بها، وغالبية دعائنا عن غير اضطرار. وأنا أتحدى أن يكون إنسان قد انتهى به أمر إلى الاضطرار ولا يجيبه الله. ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: {... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29]. والله سبحانه يخاطب الإِنسان، ويحننه، مذكراً إياه ب (افعل كذا) و(لا تفعل كذا). وسبحانه قادر أن يخلقه مرغماً على أن يفعل، لكنه- جل وعلا- شاء أن يجعل الإِنسان سيدا وجعله مختاراً، وقهر الأجناس كلها أن تكون مسخرة وفاعلة لما يريد، وأثبت لنفسه سبحانه صفة القدرة، ولا شيء يخرج عن قدرته؛ فأنت أيها العبد تكون قادراً على أن تعصي ولكنك تطيع، وهذه هي عظمة الإِيمان إنّها تثبت صفة المحبوبية لله، فإذا ما غُر الإِنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله، وبما فيه من عافية، وبما فيه من قوة، وبما فيه من مال، تجد الحق يلفته: لاحظ أنك لن تنفلت مني: أنا أعطيت لك الاختيار في الدنيا، لكنك ترجع لي في الآخرة ولن تكون هناك أسباب، ولن تجد إلا المسبب، ولذلك اقرأ: {... لِّمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار} [غافر: 16]. كأن المُلْكَ- قبل ذلك- أي في الدنيا- كان للبشر فيه شيء لمباشرتهم الأسباب هذا يملك، وذلك يملك، وآخر يوظف، لكن في الآخرة لا مالك، ولا مَلِكٌ إلا الله، فإياكم أن تغتروا بالأسباب، وأنها دانت لكم، وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها؛ لأن مرجعكم إلى الله. {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)} اذكروا أننا قلنا من قبل: إن الله هدى الكل.. بمعنى أنه قد بلَّغهم بمنهجه عبر موكب الرسل، وحين يقول سبحانه: {فَرِيقاً هدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضلالة} فالمقصود هنا ليس هداية الدلالة، لكن دلالة المعونة. وقد فرقنا بين هداية الدلالة وهداية المعونة. وقوله الحق {فَرِيقاً هدى} أي هداية المعونة؛ لأن هذا الفريق أقبل على الله بإِيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة، وبغّضه في المعصية، وأعانه على مهمته. أما الذي تأبّى على الله، ولم يستجب لهداية الدلالة أيعينه الله؟ لا. إنه يتركه في غيِّه ويخلي بينه وبين الضلالة، ولو أراده مهديًّا لما استطاع أحد أن يغير من ذلك. وسبحانه منزه عن التجني على أحد من خلقه، ولكن الذين حق عليهم الضلالة حصل لهم ذلك بسبب ما فعلوا. {... إِنَّهُمُ اتخذوا الشياطين أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ} [الأعراف: 30]. إن من يرتكب المعصية ويعترف بمعصيته فهذه تكون معصية، أمّا من يقول إنها هداية فهذا تبجح وكفر؛ لأنه يرد الحكم على الله. وخير للذين يرتكبون المعاصي أن يقولوا: حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا، أما أن يرد العاصي حكم الله ويقول: إنه الهداية، فهذا أمره عسير؛ لأنه ينتقل من مرتبة عاصٍ إلى مرتبة كافر والعياذ بالله. {... وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ} [الأعراف: 30]. لأنهم يفعلون ما حرم الله، وليتهم فعلوه على أنه محرّم، وأنهم لم يقدروا على أنفسهم، ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية في الفعل. وهذا الأمر يشيع في معاصٍ كثيرة مثل الربا، فنجد من يقول: إنه حلال، ونقول: قل هو حرام ولكن لم أقدر على نفسي، فتدخل في زمرة المعصية، ولا تدخل في زمرة الكفر والعياذ بالله، ويمكنك أن تستغفر فيغفر لك ربنا، ويتوب عليك، ولكن أن ترد الحكم على الله وتقول إنه حلال!! فهذا هو الخطر؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية وتتردى وتقع في الكفر، اربأ بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن آدم خطاء، وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قدَّر أن عبيده يخطئون ويصيبون، ومن رحمته أنه شرع التوبة، ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة، فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا تستطيع أن تخرج منه؟. نداء الايمان |
|
|
|

|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تفسير الشيخ الشعراوي سورة السجدة 23-25 | امانى يسرى محمد | قسم تفسير القرآن الكريم | 0 | 10-20-2025 10:41 PM |
| تفسير الشيخ الشعراوي سورة السجدة 18-22 | امانى يسرى محمد | قسم تفسير القرآن الكريم | 0 | 10-20-2025 10:36 PM |
| تفسير الشيخ الشعراوي آيات 7-8-9 سورة السجدة | امانى يسرى محمد | قسم تفسير القرآن الكريم | 0 | 10-20-2025 06:55 AM |
| (تفسير اول ثلاث آيات من سورة السجدة)الشيخ الشعراوي | امانى يسرى محمد | قسم تفسير القرآن الكريم | 0 | 10-20-2025 06:20 AM |
| تفسير الشيخ الشعراوي أية( 2 الى 8 )سورة الاسراء | امانى يسرى محمد | قسم تفسير القرآن الكريم | 0 | 10-01-2025 05:39 PM |
|
|