

 |
 |
 المناسبات
المناسبات |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾[التوبة:58]:
المنافقون أعداء النجاح، ورواد السخرية من المؤمنين، ولن يجدوا أنسب من غزوة تبوك لإطلاق حملتهم هذه، فكيف سيواجه هؤلاء الفقراء الضعفاء جحافل أقوى دولة في الدنيا، ويقابلونها بجيش قائم في تجهيزه على التبرعات، ويحتاج لنصف صاع وحبة تمر! ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾[التوبة:58]: لن يسلم من ذمِّ المنافقين أحدٌ، فلا المتصدِّقون سلِموا، ولا الممسكون، لا المكثِرون ولا المُقِلّون. . ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾[التوبة:58]: منظار الشك واتهام النوايا فضلا عن أنه غير موضوعي، فهو ضد ما أمر الله به من الحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. . ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾[التوبة:58]: اللمز داء يعبِّر عن نفوس المنافقين المريضة، فالمرء يطلب عيب غيره بمقدار تشرُّب قلبه بهذا العيب. قال عون بن عبد الله: «ما أحسب أحدا تفرَّغ لعيب الناس إلا من غفلة غفَلها عن نفسه«. السخرية بالآيات واستعمالها في المزاح دائرة محظورة، وقد تزل بصاحبها –دون أن يشعر- نحو النفاق. . ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾[التوبة :84]: صلاتك عليهم ووقوفك على قبورهم نوع من الشفاعة فيهم، والكافر لا تنفعه شفاعة، وفيه دليل على تحريم الصَّلاةِ على الكافِرِ، والوقوف على قبره، والدُّعاء له، والاستغفار. . ﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ﴾[التوبة :88]: رسول الله ﷺ يتقدم موكب التضحية، ومن ورائه كل داعية صادق، عليه أن يدعو الناس بحاله قبل مقاله، وعمله قبل لسانه.  . ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة :89]: من الذي أعدَّ؟! لو أن ملكا من ملوك الأرض دعاك إلى ضيافته، لو أن أغنى أغنياء العالم استضافك في قصر من قصوره، فكيف تكون لذتك؟! فكيف والله جل جلاله هو الذي أعد وهيَّأ؟! وفيه إشعارٌ بغاية العناية الإلهية. ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ﴾[التوبة :90]: أصحاب الأعذار قسمان: قسم صاحب عذر حقيقي وهم المعذِّرون، وقسم كاذب في أعذاره، وهم المنافقون. . ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾[الأنفال: 41]: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: قُصِد به الاعتناء بشأن تقسيم الغنيمة، واستشعار مراقبة الله كي لا يشذ عنها شيء، أي كل ما غنمتموه -كائنا ما كان- يقع عليه اسم الغنيمة، حتى الخيط والمخيط. ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[الأنفال: 41]: ما أكرم الله! قسَّم الله الغنائم خمسة أقسام، فعيَّن أربعة أخماس الغنيمة للجيش المقاتل، وجعل خُمسَها لهؤلاء الخمسة.. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: «أتيت النبي ﷺ، وهو بوادي القرى، وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة، فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم».. من لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله قائلا: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟! ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾[الأنفال: 41]: تحتاج لأن تراجع إيمانك إذا اعترضت على حكم ثابت من أحكام الله، فإن الاعتراض على أمر الله يقدح في إيمانك. . ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[الأنفال : 46] : وأيُّ بيان لِفائدةِ الصَّبرِ أبلَغ وأعظم مِنْ إثباتِ معية الله للصابرين؟! ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾[الأنفال : 47 ]: في الآية تكريه شديد للمسلمين في البطر والرياء، لأن الأحوال المذمومة تزداد قبحا، ويزداد الناس منها نفورا إذا كانت من أحوال قوم مذمومين، وهم هنا الكافرون الذين خرجوا لبدر بطرا ورئاء الناس. . ما البطر؟! إذا كثرت نعم الله على العبد فصرفها إلى مرضاته، فهذا هو الشكر، وإن استعملها في المفاخرة على الأقران، والمكاثرة على أهل الزمان، فهذا هو البطر. . ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾[الأنفال: 50]: قال ابن عباس: «كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف، وإذا ولوا ضربوا أدبارهم، فلا جرم أن قابلهم الله بمثله في وقت نزع الروح». . ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾[الأنفال: 51]: نفي الظلم كناية عن عدل الله المطلق، وأن العذاب الأليم مكافئ للذنب المجازى عنه بلا إفراط ولا تفريط، فلا يظلم الله مقدار ذرة. . ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾[الأنفال: 51]: إشارة بالمعنى إلى اسم الله المؤمن. قال ابن عباس: «المؤمن أي أمَّن خلقه من أن يظلمهم». . ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾[الأنفال: 54 ]: كرَّر التذكير بقوم فرعون مرتين تأكيدا وتهديدا: كم من فرعون علا في الآخِرين، فأخذه الله كما أخذ فرعون في الأولين. . ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[الأنفال: 55]: عدم الإيمان يهوي بصاحبة إلى مرتبة شر من الدواب! . ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾[الأنفال: 56]: جمعوا ثلاث خصال: الكفر، وعدم الإيمان، والخيانة، فلا يثبتون على عهد عاهدوه، وهؤلاء عند الله شر من الحمير والكلاب، لأن الخير فيهم معدوم، والشر منهم متوقع.  . ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾[الأنفال: 57]: محق هؤلاء واجب، لئلا يسري داؤهم إلى غيرهم. . ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾[الأنفال: 59]: لا يحسب الذين كفروا أنهم أفلتوا من عقاب الله، فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، لكن لله حكمة بالغة في عدم معاجلتهم بالعقوبة، ومن جملتها: ابتلاء المؤمنين وامتحانهم، وتزود المؤمنين من طاعة يبلغون به المنازل العالية. . ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال : 67]: الذين أرادوا عرَض الدنيا هم من أشاروا بالفداء، وليس رسول الله ﷺ، وقد جاءه جبريل يبلِّغه أن يخيِّر أصحابه. . ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ [الأنفال : 67]: حقيقة الدنيا! سمَّى نعيم الدُّنيا ومتاعها عَرَضا؛ لأنَّه لا ثبات له ولا دوام، فكأنَّه يَعرِضُ لصاحبه ثمَّ يزول عنه. . ﴿لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:68]: الكتاب هو ما سبق من حكم الله بإحلال الغنائم، وهذا مما ميِّزت به هذه الأمة على غيرها من الأمم: «وأُحِلَّت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي». . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾[الأنفال : 72 ]: ﴿آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: المهاجرون.﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾: الأنصار.والآية تشير إلى التآخي بين المهاجرين والأنصار.
|
|
|

|
|
|
#26 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
الجزء الحادى عشر
﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[التوبة: 94]: الله مُطَّلِعٌ على الضمائِر كاطلاعه على الظواهر، فأي عقل في الاستخفاء منه؟! . ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾[التوبة: 95]: إخبار بالمستقبل: بما سيلقى به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو. . ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾[التوبة: 95]: قال الرازي: «خبث باطنهم رجس روحاني، فكما يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية، فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى، خوفا من سريانها إلى الإنسان، وحذرا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال». . ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 109]: قلَّما تاب ظالم، وقلَّما ردَّ المظالم، والسبب أن الله عاقبه على ظلمه بحرمانه من الهداية. ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: 110]: لا نجاة للمنافق مما انحدر إليه إلا أن يتوب توبة صادقة، يتقطع منها قلبه ندما وأسفا. 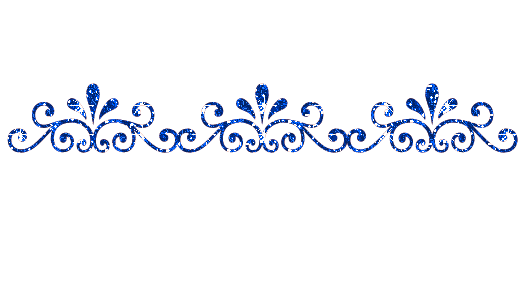 . ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله﴾[التوبة: 111]: قال الزمخشري: «لأن إخلاف الميعاد قبيح، لا يُقْدِم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم، فكيف بِالغَنيِّ الذي لا يجوز عليه قبيح قط؟». . ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[التوبة: 112]: تسابقوا إلى التَّحلِّي بهذه الخصال ، واحرصوا على بلوغ أوفى رجات الكمال. . ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾(التوبة:121): حتى قطع الطريق إلى العمل كل يوم مكتوب في ميزان حسناتك، إذا أصلحتَ نيَّتك. . ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾(التوبة:122): قال القرطبي: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم». . ﴿وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾(التوبة:122): من أهم نيات طلب العلم نشره، وليس كما يفعل البعض من التباهي به والتكبر على الخلق. 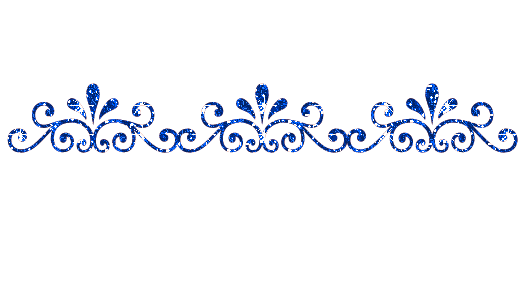 . ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾(التوبة:123): قال السيوطي: «فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين». . ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ﴾(التوبة:123): من سُنن الجهاد البدء بالعدو الأقرب فالأقرب، وليس أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك! ففي الحديث: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل». صحيح الجامع رقم: 1129 . ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ﴾(التوبة:123): وفي الحديث: «أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجلَّ». السلسلة الصحيحة رقم: 1496 . ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾(التوبة:123): معية الله للمتقين معية نصرة وتوفيق وتأييد وإعانة وتثبيت، وكل ما يحتاجونه. . ﴿وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا﴾(التوبة:124): لاحظ تواصي المنافقين بالنفاق، وتثبيتهم لبعضهم البعض حتى لا يؤمنوا! . ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾(التوبة:124): تعرضك لآيات القرآن يزيد من إيمانك، وغيابك عنها قراءة وتدبرا سبب نقص إيمانك. . ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾(التوبة:128): ترغيب للعرب في الإيمان بالنبي ﷺ وطاعته، فهو منكم، وكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا عائد إليكم. ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾(التوبة:129): خصَّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، فإذا أحاط الله به فقد أحاط بمن دونه، فكيف لا تتوكل عليه؟! . ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾(التوبة:129): قال ابن عباس: «العرش لا يقدر أحدٌ قدرَه»، فهذه عظمة العرش، فكيف بعظمة رب العرش؟! ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾﴾(يونس:1): ثلاثة معان لحكمة! الحكيم هو ذو الحكمة، أو الحكيم بمعنى الحاكِم، أو الحكيم بمعنى المُحكَم ضد تسلل الباطل، فلا كذب فيه ولا تناقض ولا اختلاف. . ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ (يونس:4): يا من طالت غيبته: ارجع إليه طوعا قبل أن ترجع إليه بالموت قهرا. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ (يونس:4): قال الضحاك: «يُسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله السموات والأرض إلى يوم يُسقونه ويُصبُّ على رؤوسهم». 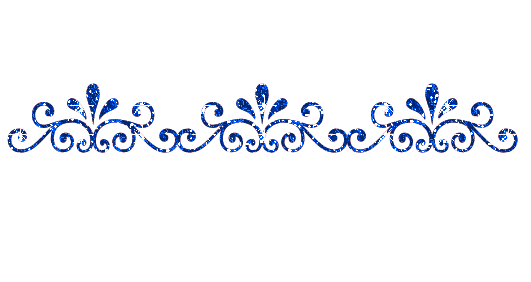 . ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (يونس:4): لماكانت الشمس أعظم حجما خُصَّت بالضياء، لأن له سطوع ولمعان، وهو أعظم من النور، ومن ضخامة حجم الشمس أنها يمكن أن تحوي 1.3 مليون كرة أرضية! ﴿ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (يونس:4): لاحظ دقة التعبير القرآني! فالضوء أقوى من النور، والضوء يأتي من إشعاع ذاتي، فالشمس ذاتية الإضاءة، فإذا استقبل القمر ضوءها عكس النور. ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾(يونس:31): من رحمة الله بنا أن لم يقصر رزقنا على جهةٍ واحدةٍ؛ بل رزقنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا. . ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾(يونس:32): قال القرطبي: «حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد». . ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس:40): يعلم الله أهل الإفساد في الأرض، وليس بعد العلم إلا الحساب والعقاب. ﴿فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ (يونس:41): عار أن يعمل أهل الباطل، ويتخلف عن العمل أهل الحق، وعار أكبر أن يجتهد أقوام في السعي إلى النار، ويكسل عاشق الجنة. 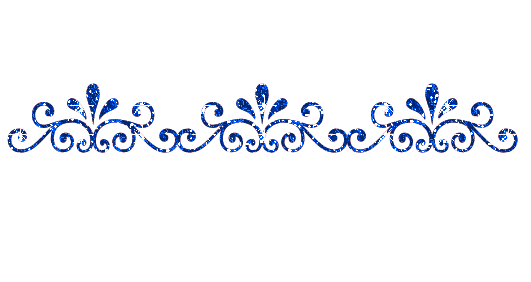 . ﴿أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (يونس:41): في البراءة استعمل الفعل المضارع: (أعمل) و (تعملون) للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والمستقبل. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ (يونس:42): الهداية بيد الله وحده، وإذا غاب القلب لم تنفع الأذنان. . ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾(يونس:49): سيد الأنبياء لا يقدر على دفع ضر عنه ولا جلب نفع له إلا بإذن الله، فمتى يتعلم التواضع منه أهل الكِبْر والخيلاء؟! . ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾(يونس:49): لا أحد يموتُ إلَّا بعد انقضاءِ أجَلِه، ولا يُقتَل المقتول إلا على هذا الوجه. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾(يونس:59): احذر الفتوى بغير علم! قال ابن كثير: «وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله، أو أحل ما حرم، بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها، ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة«. ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(يونس:60): استفهام قُصِد منه الوعيد والتهديد الشديد لبيان هول ما سيلقونه من عذاب ﴿وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(يونس:65): لا يحزنك تهديد واستهزاء وسخرية وتآمر أهل الباطل، فحربهم ليست معك، بل مع الله العزيز. . ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾(يونس:65): انظر إلى أعدائك بنظر الفناء، لترى أعمالهم وأقوالهم وتهديدهم كالهباء، فمن شاهد قوة الله وعزته رأى كل العزة والقوة له، ولا قوة لأحد ولا حول له، وهو تعليل للنهي السابق. كأنه قيل: لم لا أحزن؟ فقيل: إن العزة لله. . ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾(يونس:66): حين يسيطر الشيطان على القلب، يقوده إلى الوهم، فلا يتبع المشركون شركاء لله على الحقيقة، وإنما سموهم شركاء لجهلهم. . ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾(يونس:66): الخرَص هو الكذب أو القول بتخمين، ومن أبشع الضلالة: أن يقضي أقوام أعمارهم في خدمة باطل يظنونه حقا. ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾(يونس:71): صدق التوكل هو باعث القوة في القلب لإعلان هذا التحدي، والتقدم بمثل هذا الطلب التعجيزي. . ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾(يونس:71):ي ستطيع العبد - بتوكله على ربه- أن يلقي بأعدائه خلف قضبان العجز. 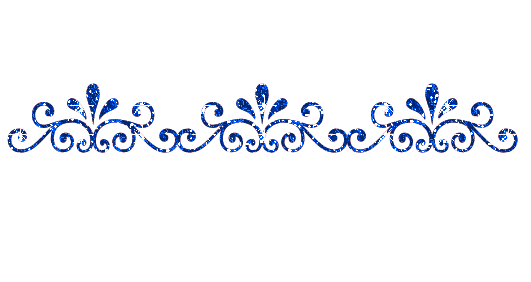 . ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [يونس: 73]: (المنذَرين) أي المكذِّبين، حيث لم يُفِد الإنذار فيهم، وقد جرت سنة الله أن لا يُهلِك قوما بالاستئصال إلا بعد الإنذار، فمن أنذر فقد أعذر. ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾(يونس:74): الطبع على القلب وحرمانه من الهداية ليس إلا عقوبة للمعتدين على الذنوب. . ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: 75]: الحق سحر، وحامل الحق ساحر! لن تنفد حجج البعض للتفلت من تبعات الإيمان. . ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾(يونس:79): يصدِّق الطاغية بمرور الوقت كذبه، فما زال فرعون يظن موسى ساحرا، ويريد أن يقابله بسحر مثله. . ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾(يونس:80): قال الآلوسي: «لا يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة، والمراد أمرهم بتقديم ما صمموا على فعله ليظهر إبطاله، وليس المراد الأمر بالسحر والرضا به». 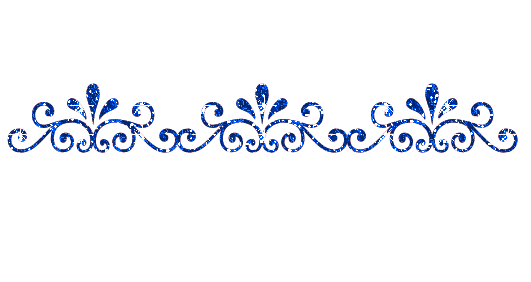 . ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾(يونس:81): قال الطاهر بن عاشور مبيِّنا طبيعة الباطل المضمحلة وزواله الحتمي:«فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنها، ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل» . ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾(يونس:81): كتب الخليفة الخامس عُمر بن عبد العزيز إلى عامله عبد الرحمن بن نُعَيْم ينصحه في سطر واحد: «أما بعد، فاعمل عمل من يعلم أنَّ الله لا يُصْلِح عمل الْمُفْسدين». . ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾(يونس:82): الإحقاق هو التثبيت، ومنه سُمِّي الحق حقا لأنه الثابت، وقول الله تعالى ﴿بِكَلِماتِهِ﴾: «فمعناه بكلماته السابقة الأزلية في الوعد بذلك» . ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾(يونس:86): قال الإمام الشوكانى: «وفي هذا الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله- دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم». . ﴿تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: لا عذر لأحد في ترك الصلاة! منعهم فرعون الصلاة، فأمرهم الله أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم. |
|
|

|
|
|
#27 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾(يونس:87):
اجعل بيتك قبلة للمؤمنين ومنارة للحائرين وواحة للمهتدين. . ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾(يونس:88): قال القرطبي: «اختُلِف في هذه اللام، وأصح ما قبل فيها- وهو قول الخليل وسيبويه- أنها لام العاقبة والصيرورة». . ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾(يونس:91): إذا طرق ملك الموت بابك، فقد أُغلِق باب القبول، فات وقت الاعتذار، بعد الركض طويلا في ميدان الاغترار! . ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾(يونس:92): كم أهلك الله فراعين أمام أعين الناس أجمعين، ليكونوا عبرة للغافلين. . ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾(يونس:92): آية لكل ظالم وكل مظلوم، وقلما يعتبر ظالم، فليعتبر بها كل مظلوم. . ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾(يونس:100): ليست هداية البشر بإرادة نبي ولا سعي ولي، وإنما بإرادة الله وتوفيقه، فلا تحمِّل نفسك فوق طاقتها في سبيل هداية أحد، وَوكِّل أمره إلى الله. 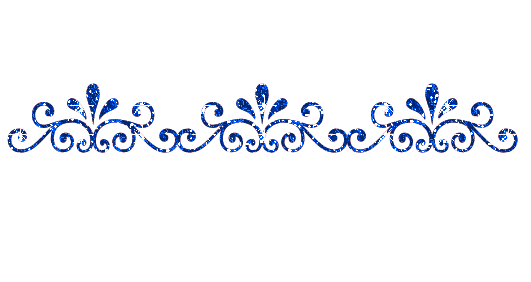 . ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾(يونس:101): قال السيوطي: «في الآية دليل على وجوب النظر والاجتهاد، وترك التقليد في الاعتقاد». . كَيف تخَاف فَوات شيء من الْخَيْر أراده الله بك، وإن لم يردهُ بك، فَمن الذي يقدر على أن يعطيك إياه؟ . ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [يونس: 108] اختيار وصف الرب: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ للتنبيه على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده، ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم، وهذا شأن من يربي، أي يسوس الأمر ويدبِّره. . ﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [يونس: 108]: كلُّ من تُعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك، والرب سبحانه إنّما يعاملك لتربحَ أنت عليه أعظمَ الربح وأعلاه. . ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ [يونس: 109] اتباع الحق سيجر عليك المتاعب، لذا تحتاج دوما إلى الصبر.. تحتاج إلى صبر لاتباع الحق وتحصيله والعمل به ثم الدعوة إليه. 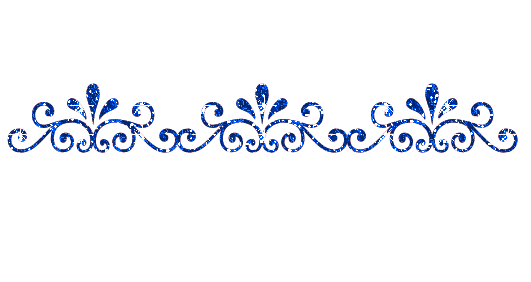 ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾[هود:3]: الاستغفار مقال، والتوبة أعمال، والتوبة أعلى. . قال البقاعي: «أشار بأداة التَّراخي إلى علوِّ رُتبةِ التَّوبةِ، وأنْ لا سبيلَ إلى طلَبِ الغُفرانِ إلَّا بها». . ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾[هود:3]: التوبة وعد! سمع مطرف رجلا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ، فأخذ مطرف بذراعه وقال : «لعلك لا تفعل! من وعد فقد أوجب».. قال القشيري: «توبوا إليه بعد الاستغفار، من توهمكم أن نجاتكم باستغفاركم، بل تحقَّقوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا بفضل ربِّكم، فبفضله وبتوفيقه توصَّلتم إلى استغفاركم، لا باستغفاركم وصلتم إلى نجاتكم». . ﴿ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾[هود:3]: سمَّى منافع الدُّنيا متاعا؛ للتَّنبيه على حقارتها، ونبَّه مع هذه الحقارة على أنها مُنقَضية، فقال: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، فدلَّت الآية في شدة إيجاز على كَونِ الدنيا حقيرة زائلة. . ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾[هود:3]: المراد بالفضل الأول: العمل الصالح، والفضل الثاني: ثواب الله، فالجملة وعدٌ من الكريم بحسن مجازاة الصالحين. . ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾[هود:3]: تتفاوت الدرجات في الآخرة بحسب تفاوت أعمال العباد. قال يحيى بن معاذ: «إنما ينبسطون (ينشطون ويجتهدون) إليه على قدر منازلهم لديه». المنافق مستعد للحلف كاذبا ليُرضي الخلق، أما راى الله فآخر اهتماماته: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾. . ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾: إذا لم تستطع أن تتخلص من السيئات، فزاحمها بكثرة الحسنات، وستغلب الكثرة القِلة ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾: اجعل من نياتك عند الشروع في الطاعة أن تمحو بها أثر سيئة. . ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾: شرع الله الصدقة من أجلك أنت أولا قبل الفقير. . ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾: كان بعض المتصدقين يضع الصدقة في يده، ثم يدعو الفقير لأخذها، لتكون يد الفقير هي العليا، ويده المنفقة هي السفلى! 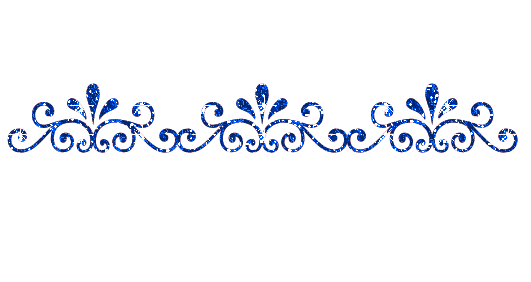 . توبة مالية!! إذا ابتليت بذنب وتريد أن تتطهر منه، فاستعن بالصدقة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ . ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ﴾: قال ابن كثير: «هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها». . ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾: كل طاعاتك يراها الله، فكيف تشرك فيها غيرك؟! . ﴿والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا﴾: اتخذ النفاق في العهد النبوي أشكالا لا يُتصَوَّر أن يتسلل إليها النفاق، فكيف بعهدنا اليوم؟! الحذر أوْلى. . ﴿فيه رِجالٌ يُحبونَ أَنْ يَتَطَهّروا﴾: إذا أردت أن تطهِّر قلبك وتزكِّي روحك، فاجلس في مسجد، واذكـر الله تعالى فيه. . ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾: ماذا تساوي نفوسنا المعيبة -وإن طهرت- حتى يشتريها الله منا بكل هذا الثمن، لذا قال الحسن البصري: « بايعهم والله فأغلى ثمنهم».. قال محمد بن الحنفية يحثك على تزكية نفسك بالعمل الصالح:«إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها».. أنت لا تملك نفسك، ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن المالك، فإنما يتصرف في ما اشتراه منك وبعته له، وأعطاك في المقابل الجنة، أرجعت في بيعتك؟! أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟! وإذا بعت.. أيحسن لمن باع شيئا أن يغضب على المشتري إذا تصرَّف فيه أو يتغيرقلبه تجاهه إذا أنفقه؟ وماذا لنا فينا حتى نتكلم!!. كيف بعت هذه النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة؟! وبلذة لا تبقى سوى ساعة؟! وهبها بقيت أياما أو أعواما فماذا تساوي بجوار لذة الخلد؟! وبعتها لمن؟! لأعدى أعدائك: شيطانك!. حُكِي عن مالك بن دينار أنه مرَّ بقصر يُبنَى، فسأل الأجراء عن أجرتهم، فأجابه كل واحد منهم بأجرته، ولم يجبه واحد، فقال: ما أجرتك؟ فقال: لا أجر لي؛ لأني عبد صاحب القصر، فقال مالك: إلهي .. ما أسخاك، الخلق كلهم عبيدك، كلَّفتهم العمل ووعدتهم الأجر.. البائع لا يستحقّ الثمن إذا امتنع عن تسليم ما باع، فكذلك لا يستحق العبد الجنة إلا بعد تسليم النّفس والمال على موجب أوامر الشرع، فمن قعد أو فرّط فغير مستحق للجزاء. 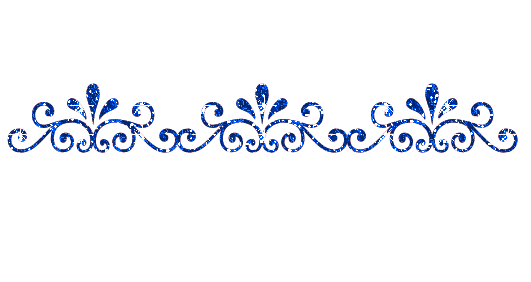 . تأمل هذا الوصف البليغ في الولاء والبراء: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾، فاقتفِ أثر خليل الرحمن، وتبرأ من كل عدو لك ولدينك ولرسولك وللمؤمنين. . تأمل كيف اجتمعت صفة الحلم والغلظة في شخص واحد: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيم﴾، فالحلم ليس معناه التهاون في أمر الدين. . ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ صحابة..مجاهدون..في معية النبي ﷺ، وتكاد قلوبهم أن تزيغ، وبعضنا واثق من قلبه، ومطمئن على إيمانه! على أي اساس؟! . ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَة ﴾: وصف الله العسر بأنه ساعة من نهار؛ كي لا تضجر من الأقدار! ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾: قال ابن القيم: «وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا، قبولا وإثابة».. قال ابن القيم: التوبة نهاية كل عارف، وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة، لذا كان ﷺ في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره، وأنزل الله بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها ﷺ بنفسه: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ . ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾: تحتاج لأن يتوب عليك أولا لتتوب، فالتوبة ليست مجرد قرار شجاع، هي قبل ذلك هداية ورحمة وتوفيق من الله. ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾: أضيق ما يكون الأمر قُبيل الفرَج! . ﴿وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ﴾: قال مجاهد: «ما كان من ظن في القرآن فهو يقين»، فلما أيقنوا ألا ملجأ إلا الله، صدق منهم اللجوء إليه، فتداركهم بالشِّفاء، وأسقط عنهم البلاء. . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾: كونوا معهم، ولا تتفردوا في السير من دونهم، كي لا يستفرد بكم شيطان في الطريق، فالجماعة بركة، والفرقة عذاب وضياع. . ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾: لن تستطيع أن تكون تقيا إلا إن كنت في بيئة صالحة! . ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾: الصدق من أهم معايير اختيار الصحبة، فلا يصلح أن تصاحب كاذبا. 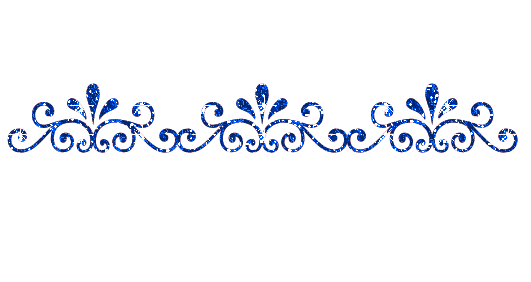 ﴿وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾: والوطء في سبيل الله هو أن تدوس في أرض العدو بما يغيظه، فإن العدو يأنف من وطء أرضه، وممكن أن يكون الوطء استعارة لإذلال العدو وإغاظته، فكل عمل تغيظ به أعداء الله، فلك به أجر، ولو كان خطوة واحدة. . ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً ﴾: لا تحقرن صغيرة من خير، فأصحاب الأعراف يوم القيامة يوقفون عن دخول الجنة، بسبب نقصان حسنة واحدة! . تنزل الآية على القلوب، فتكون سبب في زياد إيمان قوم، وزيادة رجس -أي كفر وشك- قوم آخرين ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾. . ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾: قصة حديث تشرح آية!. بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما الأول فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فقال ﷺ: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 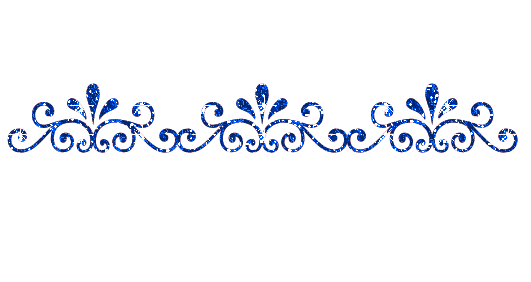 . ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾: إعراض مديره عنه يقلقه، فكيف بإعراض الله؟! . ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾: سين: لماذا صرف الله قلوبهم؟! جيم: لأنهم انصرفوا، فصرف الله قلوبهم عن الهدى؛ عقوبة على انصرافهم أولا. . ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾: المنافق تُقلِقه سورة! فكيف بالقرآن بأكمله؟! . ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله﴾: قل لكل شيء فقدته، ولكل غالٍ هجرك، ولكل قريب تخلى عنك: حسبي الله .. يكفيني ويؤويني. آية : ﴿وبشِّرِ الذينَ آمَنوا..﴾: تبشير المؤمنين سُنَّة يغفل عنها الكثيرون، وما أكثر ما قال رسول الله ﷺ كلمة (أبشِر) لأصحابه، وبها أمرنا: «بشِّروا ولا تنفِّروا». . آية : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: قال السعدي: «مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله». ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ﴾: فرِّغ قلبك من همومك وتدبيرك، وفوِّض أمرك لوأسلِم قيادك لمن وعدك بتدير الأمر لك ولغيرك. . ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ﴾: قال سهل التستري: «يقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله خير له من خيرته لنفسه». . ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾: حقيقة القدم ما قدَّموه، ويقدمون عليه يوم القيامة، والمؤمنون قدَّموا الأعمال الصالحة، والإيمان بمحمد ﷺ ، فيقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك، فهذه ثلاث تفسيرات لقدم صدق. . ﴿ يُدَبّرُ الأَمْرَ ﴾ تكررت في كتاب الله 4 مرات؛ لتنزع من قلبك أوهام أن أمرك بيد أحد غير الله. ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا﴾: لا يأمرك الله بترك الدنيا، ولكن بعدم الاطمئنان بها وألا تركن إليها، فتقدِّمها على آخرتك، وتحصِّل لذاتها وشهواتها بأي طريق فتهلك!! 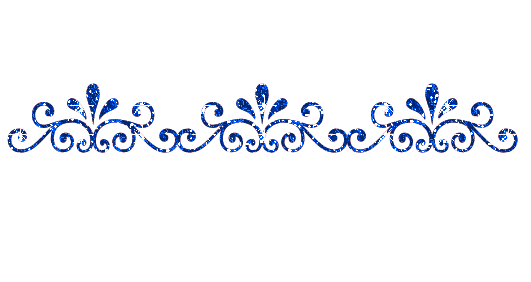 . ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾: ليست الهداية درجة واحدة ولا الإيمان، بل درجات، وتتناسب هدايتك طرديا مع إيمانك، فكلما زاد إيمانك زادت هدايتك. . ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾: الإيمان باقة نور يهتدي به المؤمنون في ظلمات الفتن ومتاهات الغربة، حتى يصلوا إلى الهدف المنشود: الجنة. . ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾: قال ابن جريج: يُمثَّل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره، يعارِض صاحبه ويبشِّره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيُجعَل له نوره من بين يديه حتى يُدخِله الجنة، فذلك قوله تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ . . ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. الدعوى هنا الدعاء، ومعنى قولهم سبحانك: اللهم إنا نسبِّحك وننزهك عما لا يليق بك، فعبادة أهل الجنة التسبيح والحمد ، وذلك ليس على سبيل التكليف، بل على سبيل التلذذ والابتهاج بذكر الله، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة. . ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾: قال الآلوسى: «وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء، ويهرع إليه في الشدة، واللائق بحال العاقل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء، فإن ذلك أرجى للإجابة، ففي الحديث الشريف: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». . ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾: قال أبو الدرداء: «ادعُ الله يوم سرائك، يستجِب لك يوم ضرائك». . ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾: ما أشبه الليلة بالبارحة! بعض من ينادون بخفيف لهجة الخطاب الديني أو تجديده! 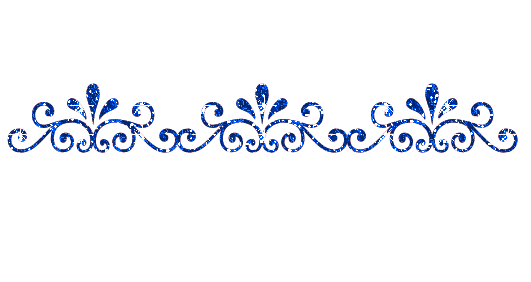 . ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾: قال الطبري: «والتبديل الذي سألوه أن يحوّل آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدًا، والحرامَ حلالا، والحلال حرامًا، فأمر الله نبيَّه ﷺ أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يُرَدُّ حكمه، ولا يُتَعَقَّب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلِّغ ومأمور مُتَّبِع». ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾: هذا سبب تعنت المنافقين والكافرين تجاه القضايا الإسلامية والأحكام الشرعية، وأما من آمن بلقاء الله فلابد له أن ينقاد لأحكامه. . ﴿ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾: ﻻ تحزن إن جحد الناس إحسانك، فمَنْ جحد فضل الخالق من قبل، كيف لا يجحد فضل المخلوق؟! . ﴿قل الله أسرع مكرا﴾: مهما أسرع الماكرون وتفننوا وتستروا، فقد سبق مكر الله مكرهم، لأن أحاط علما بمكرهم قبل أن يفعلوه، وقدرة على إبطاله بعد أن يفعلوه. ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾: مشركون دعوا الله حين أحاطت بهم الأمواج، فنجاهم الله، فكيف تيأس وتنقطع عن الدعاء مع إيمانك؟! . قال مكحول: ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر، والبغي، والنكث. قال تعالى: {ومن نكث فإنما ينكث على نفسه} وقال: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} [فاطر: 43]، وقال: {إنما بغيكم} على أنفسكم "[يونس: 23] . (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم): أنفع موعظة ما كانت من أجل منفعتك أو صرف السوء عنك، ولذا فهذه صيحة تحذير وصرخة نذير: أنت لا تضر إلا نفسك! ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾: البغي سهم سيرتد إليك عاجلا أو آجلا! ﴿وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا﴾: الاغترار بالقوة أول علامات الانهيار. . ﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾: قال القرطبي: «المضطر يجاب دعاؤه، وإن كان كافرا، لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب». . ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾: الدنيا أقصر ما تكون، وكأنها موسم زراعة واحد!! . ﴿كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾: جملة كفيلة بأن تزهِّدك في الدنيا بأسرها لأنها زائلة ومنسية، وترغِّبك في الآخرة الخالدة. . ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾: قال ابن كثير: «لما ذكر الله الدنيا وسرعة زوالها، رغَّب في الجنة ودعا إليها، وسمّاها: دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات». . ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾: من أجاب النداء من الدنيا دخلها، ومن أجاب النداء من القبر حُرِمها. . ﴿ وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ﴾: تجيب أمك وأباك إذا ناداك، ولا تجيب ربك إذا دعاك، ودعوته لك إلى سعادة الأبد في جنة الخلد لتكون مثواك! . بقدر إحسانك في الدنيا تكون زيادة نعيمك في الجنة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ 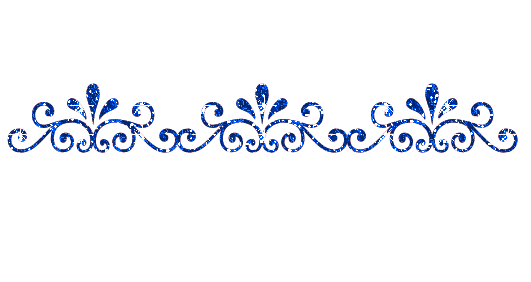 . ﴿وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ﴾: قال السعدي: «لا ينالهم في الجنة أي مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكدَّر». . ﴿وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ﴾: تغير وجه صاحبك علامة على نزول مكروهٍ به، فتفقَّد أحواك صاحبك عند تغير وجهه. . ﴿بل كذبُوا بما لم يُحيطوا بعلمه﴾: الإنسان عدو ما جهل! . ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾: النظرة واحدة لكن الأثر مختلف بحسب نوع القلب. قال ابن كثير: «المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار: (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا) ». . ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾: عشرات السنين تصبح بعد معاينة الآخرة أقصر ما تكون، وكأنها لحظات تعارف. . وعد الله بالنصر قائم وقادم لا محالة، لكن لا يلزم أن يراه المستضعفون اليوم، فالله قال لرسوله: ﴿فإمّا نرينّك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون﴾. . ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: قال ابن عاشور: «وقد عبَّر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي: أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين». . ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾: وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم بشرطه، وشرطه: التدبر. . ﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾: جاءت كلمة «الشفاء» قبل كلمة الهداية، لتبيِّن أن إخراج ما في القلب من أهواء وأمراض مطلوب لحصول هداية القلب. . ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ هذه من أشد آيات المراقبة، فهذا علمه بحركات الذرات، فكيف علمه بحركات لعباد؟! 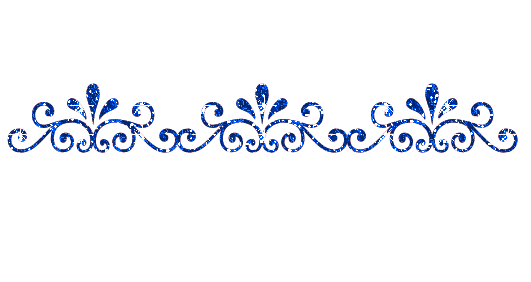 . ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: أي لا خوف يخافه خائفٌ عليهم، فهم بمأمن من أن يصيبهم مكروه، وليس المعنى أنهم لا يخافون، لكن إذا اعتراهم خوفٌ ينقشع عنهم باعتصامهم بالله وتوكلهم عليه. ﴿وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا، فذلك حزن عابر لا يستقر، بل يزول بالصبر وذكر الأجر، ولا يلحقهم الحزن الدائم المؤدي لكسر النفس والاكتئاب. . ﴿لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: قال ابن عاشور: «فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه، وأن لا يحل بهم ما يحزنهم، ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبه، كان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف الخائف عليهم». . ﴿لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾:قال السعدي: أما البشارة في الدنيا، فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق.. وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم.. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم. . اطمئن واستبشِر!﴿لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾: كل ما وعد به الله فهو حق، ولا يمكن تغييره أو تبديله أو الرجوع عنه، لأنه الصادق في قوله، ولا يقدر أحد على مخالفه ما قدره وقضاه، ومن ذلك وعودُه للمؤمنين، ولذا قال بعدها مبشِّرا: (ذلك الفوز العظيم). . ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾: الداعية لا يرجو بدعوته مالا ولا جاها، وكلما زهد داعية في دنيا الناس أقبل الناس عليه، ليفيدهم في أمر آخرتهم. . ﴿ إن أجري إلا على الله ﴾: فلا تأبه إن شكرك الناس على صنع المعروف أو نسوك، ولا تحزن لجحود الناس، لأنك تستلم أجرك من وجهة واحدة: الله رب العالمين. 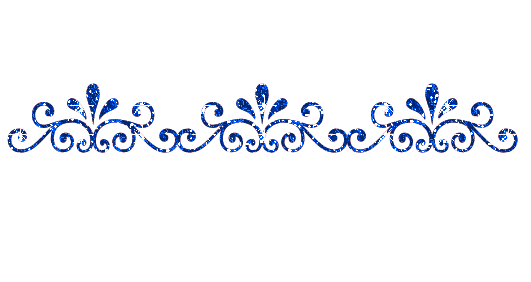 . ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾: يظن الظالم أن الناس كلهم مثله، فيرميهم بالداء الذي فيه، ولا يتصور ان أحدا يعمل لمهمة سامية وغاية نبيلة، أو رجاء ثواب الله والدار الآخرة. . ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: أي يا رب لا تمكِّنهم من عذابنا، لئلا يقول الظالمون وأتباعهم: لو كان هؤلاء على الحق لنصرهم الله! . ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ﴾: الذرية هم الشباب، وهم أمل المستقبل ومفتاح التغيير. . ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾: شكر نعمة الإجابة! قال ابن عاشور: وفرَّع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم. ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾: ما فائدة أمر المستقيم بالاستقامة؟ فموسى وهارون حازا أعلى استقامة، وهي استقامة النبوة. جيم: الأمر بالدوام عليها. . ﴿ وَلا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾: أول الانحراف عن طريق الاستقامة سببه اتباع طريق المنحرفين، فحذر المؤمن وخوفه الدائم من الانحراف من أهم أسباب الاستقامة. . ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾: الاستقامة على فعل الطاعات، من أعظم أسباب إجابـة الدعوات. . ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: قال البقاعي: في كل زمن وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسول، لأن العلة الاتصاف بالإيمان الثابت. ﴿وإن يُردكَ بخيرٍ فلَا رادَّ لفضّله ﴾: لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها، فمن يحرم من أراد الله عطاءه، ومن يُشقي من أراد الله إسعاده؟! . ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾: الاستغفار جسر يوصلك إلى التوبة. 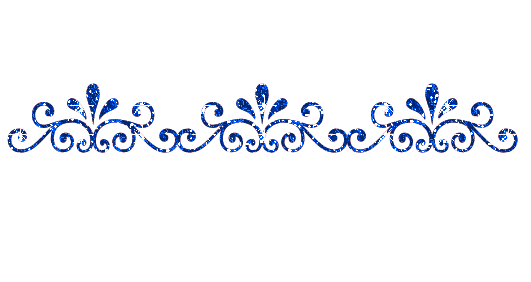 ﴿وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ﴾: أعظم متعة تجدها في قلوب التائبين المستغفرين. . خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رجع قالوا: ما رأيناك استسقيت، قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ: ﴿وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هود: 52] . ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾: قال سعيد بن جبير: من عمل حسنة كُتِبَت له عشر حسنات، ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة، فإن لم يعاقب بها في الدنيا، أُخذ من العشرة واحدة، وبقيت له تسع حسنات، لذا قال ابن مسعود: «هلك من غلب آحاده أعشاره». |
|
|

|
|
|
#28 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
الجزء الثانى عشر ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾[هود: 7]: قال أبو جعفر الطبري: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾، أفيعجز من خلق ذلك من غير شيء أن يعيدكم أحياءً بعد أن يميتكم؟!». . ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[هود: 7]: قال البقاعي: «ففي ذلك الحثُّ على محاسنِ الأعمال، والترقِّي دائما في مراتبِ الكمالِ». . ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾[هود: 11]: المراد بالذين صبروا المؤمنون، لأن الصبر من لوازم الإيمان، ولا إيمان لمن لا صبر له. . ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾[هود: 11]: استعمل وصف (صبروا) بدلا من (آمنوا)، لأن المراد مقارنة حالهم بحال الكفار في قول أحدهم: ﴿إنه ليؤس كفور﴾ [هود: 9].  . ﴿أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾[هود: 13]: الإعجاز بالتحدي! تحدى الله عز وجل الخلق أن يأتوا بمثل القرآن، فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من سور القرآن، فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فعجزوا. . ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾[هود: 39]:المؤمن الواثق بأنه على الحَقِّ لا يُزَعزِع ثقتَه مقابلة السُّفهاء لدعوته بالسُّخرية، بل يجهر بكلم ةالحق بكل قوة. . ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾[هود: 37]: قد علم الله من يصر على الكفر منهم ويموت عليه، فلماذا يطلب الله من رسوله ﷺ تبليغ الرسالة؟ والجواب: لتقوم عليهم الحجة، ويكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة . ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾[هود: 45]:قال مالك بن أنس: «الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات». . ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾[هود: 57]: الاستعمال في طاعته وإلا فالاستبدال. . ﴿إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾[هود: 57]: يا حفيظ احفظنا! اقتضت سنة الله أن يحفظ أولياءه ويخذل أعداءه.  ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾[هود: 58]:لم يقل باستحقاقه النجاة، أو بنبوته، أو لكثرة طاعته وحسن عبادته، بل قال: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾، ليعلم الجميع أن رحمة الله هي طوق النجاة، وأن أحدا لا يستوجب النجاة بسابق عمله بل بسابغ رحمة الله. . ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾[هود: 59]: عصوا رسولا واحدا، لكن رسالة الرسل واحدة، فمعصية واحد كمعصية الكل. . ﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾[هود: 59]: اتباع أمر الجبابرة يحشرك معهم يوم القيامة. قال ابن عرفة: دخلت ﴿كل﴾ على ﴿جبار﴾، ولم يقل: اتبعوا كل أمر جبار عنيد، وهذا هو الصواب؛ لأن المراد أنهم اتبعوه في ما فيه مخالفة للشرع، فلم يتبعوا كل أمره. . ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[هود: 60]: استعمل مع الدنيا اسم الإشارة ﴿هذه﴾، لقصد تحقيرها وتهوين أمرها عند مقارنتها بلعنة الآخرة. . ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾[هود: 60]:ما فائدة (قَوْمِ هُودٍ) مع أنه أمر معلوم؟! ل لإشارة إلى أنَّ استِحْقاقَهم للبُعْد بسبَبِ ما جرَى بينَهم وبين هودٍ عليه السلام وهم قومُه؛ فيكون هذا تعريضًا خفيا بمشركي قريش الذين آذوا رسول الله ﷺ، وأنهم سيلاقون بتكذيبهم لرسولهم ما لقيه قوم هود لمخالفة نبيهم. . ﴿قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾[هود: 62]: يتغير رأي الناس فيك إن واجهتهم بما يكرهون ولو كان حقا، ويحبونك لو وافقتهم ولو كانوا على باطل. . ﴿قال تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾[هود: 65]: استُدِلَّ به في إمهالِ الخَصمِ ثلاثة أيام. قال الأوزاعي: «كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام، ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه». ﴿نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾[هود: 66]: الخزي هو الذل العظيم الذي يبلغ بصاحبه حد الفضيحة، وسمى الله هذا العذاب خزيا؛ لأنه فضيحة باقية يعتبر بها من بعدهم من الأمم. . ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾: قال الإمام السيوطي: »فيه مشروعيَّةُ الضِّيافة والمبادرة إليها، واستحباب مبادرة الضَّيف بالأكل منها». . ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾[هود: 69]: فيه إشارة إلى أن السَّلامِ مِن ملَّةِ أبينا إبراهيم عليه السَّلام . ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾[هود: 75]: والحليم: هو الصبور على الأذى، المقابل له بالإحسان، والأواه: كناية عن شِدَّةِ اهتمامه بالنَّاس، وتأوُّهه لآلامهم، وهذا شأن كل داعية. . ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾[هود: 80]: هذا حالُ المؤمنِ إذا رأى مُنكَرا لا يقدِر على إزالته؛ أن يتحَسَّر على فقد القوة أو المعين على دفعه.  . ﴿قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾[هود: 81]: جواز رؤية البشر للملائكة، كما رأتْهم سارة امرأة الخليل عليه السَّلام، وكما رأى الصَّحابة جبريلَ على هيئة أعرابي، وكما نزل جبريل في صورة دِحيةَ الكَلبيِّ. . ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾[هود: 81]: عاجَلوه بالبشرى ليطمئن. ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾[هود: 81]: قال قتادة: «كانت مع لوط حين خرج من القرية، فلما سمعت العذاب التفتت وقالت: وا قوماه، فأصابها حجر، فأهلكها». . (هُوَ كَاذِبٌ﴾[هود: 93]: تعريض بكذبهم في ادعائهم القدرة على رجمه، وفي نسبته إلى الضعف والهوان، وأنهم لولا رهطه لرجموه. . ﴿وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾[هود: 93]: هكذا يجب ن تكون ثقة كل مؤمن بوعد ربه.  . ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾[هود: 94]: لا نجاة لأحد من العذاب ولو كان نبيا، إلا برحمة الله. . ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ﴾[هود: 95]: قال ابن عاشور: «ووجه الشبه: التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال، وهو عذاب الصيحة». . ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾[هود: 96]: الآيات هي الآيات التسع، والسلطان المبين أي: حجَّة بيِّنة، وكل سُلْطَان ذكر فِي الْقُرْآن هو بِمَعْنى الْحجَّة. . ﴿ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾[هود: 96]:سلطان قوة يقهر قوة فرعون، وسلطان حجة يقنع القلوب، فيشمل القوالب والقلوب، وهما علامة الكمال لكل داعٍ إلى الخير. ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾[هود: 99]:الرفد هو العطاء، وكأن مكافأة فرعون لقومه على اتباعهم له هي اللعنة التي تصيبهم في الدنيا والآخرة، وهو لون من ألوان التهكم لا يخفى. ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾[هود: 100]: من هذه القرى المهلكة ما آثارها قائمة يراها الناظرون، كآثار فرعون وثمود، ومنها ما زالت أثارها وصارت كالزرع المحصود، فلم يبق منه شيء كديار قوم نوح ولوط. . ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾[هود: 101]:قال أبو الفتح البستي:من استعان بغير الله في طلب .. فإن ناصره عجز وخذلان . ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ﴾[هود: 104]:تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف على أجل معدود، وكل ما له عدد فهو منتهٍ، وكل منته لا بد أن يفنى، فإذا فني أقام الله القيامة، وكل آت قريب. . ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾[هود: 105]:في حديثِ الشَّفاعة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ولا يتكَلَّمُ يومَئذٍ إلَّا الرُّسُل، ودعوى الرُّسُلِ يومَئذٍ: اللهُمَّ سلِّمْ سلِّم». . ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾[هود: 106]:تخيل التنفس داخل النار، وسط جوها المتصاعد باللهب والدخان، فيتنفس المسكين نارا تحرق جوفه وأحشاءه، فما أشده عذابه.  . ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾[هود: 107]: هذا أرحم استِثناء في القرآن! لأن فيه أعظم فائدة، وهو إخراج أهل التَّوحيدِ من النَّار. . ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾[هود: 108]: وصف الله هنا نعيم الجنة بأنه غير مقطوع؛ لئلَّا يتوهَّمَ واهم بعد ذِكر المشيئة: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ أنَّ ثَمَّ انقطاع في النعيم، بل هو الخلود والدوام الأبدي. . ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾[هود: 110]:اختلاف شأن الناس حول الحق سنة ربانية في كل زمان ومكان، والمصيبة إذا عمَّت خفَّت، فالجملة تسلية لرسول ﷺ وورثته من بعده. . ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾[هود: 111]: تَضمَّنَت الآية أربع توكيداتٍ لبث اليقين! التَّوكيدَ بـ (إنَّ)، وبـ (كلٍّ)، وباللَّامِ في الخبَر وبالقسَم، وبنونِ التَّوكيد؛ وذلك مبالغة في وعْد الطَّائعين وتوعد العاصين. . ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[هود: 111]: سيوفيك الله أجرك كاملا؛ لأنه الخبير الذي أحاط علما بكل ما بذلتَ، ولو كان مثقال ذرة.  . ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾[هود: 116]: قال قتادة: «لم يكن من قبلكم من ينهى عن الفساد في الأرض (إلا قليلاً ممن أنجينا منهم)». . ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[يوسف: 8]: ليست الكثرة دائما علامة خيرية أو اجتماع على الحق، أحيانا تكون عكس ذلك. . ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[يوسف: 8]: قارن بين قولهم وقول يوسف لأبيه: ﴿يا أبَتِ﴾، لتعرف سر حب يعقوب ليوسف، فلم يكن تفضيله له عن هوى أو جمال شكل، فإن مقام النبوة منزَّه عن كل هذا، لكن لحسن أدبه ورجاحة عقله، وظهور أمارات الاصطفاء عليه. . ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: 20]: رسالة لكل من تعجَّب من جريمة إخوة يوسف! قال ابن الجوزي: «كان بعض الصالحين يقول: والله! ما يوسف -وإن باعه أعداؤه- بأعجب منك في بيعك نفسك، بشهوة ساعة من معاصيك». . ﴿ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[يوسف: 25]: يدل على حرص المرأة على حياة يوسف، لكي لا يفكِّر العزيز في قتله، وهذا غاية الدهاء منها، أن تخيِّره بين خيارين ليس منهما المساس بحياة يوسف. . ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾[يوسف: 26]: دافَع عن أبشع تهمة بأربع كلمات فحسب، فالصادق واثقٌ في نفسه، متوكِّلٌ على ربه. . ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾[يوسف: 26]: لم يسبقها يوسف بالكلام سترا لها وصونا لعِرضها، فلما اتهمته زورا اضطر للدفاع عن نفسه. ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾[يوسف: 26]: قال الإمام الرازي: «إنَّما قال: مِنْ أَهْلِهَا ليكون أَوْلى بالقَبول في حقِّ المرأة؛ لأنَّ الظَّاهِر مِن حال مَنْ يكون مِن أقرباء المرأة ومن أهلِها ألا يقصِدَها بالسوء والإضرار». . ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[يوسف: 26]: كان من فطنة الشاهد، ومن لطف الله بيوسف أن بدأ بالاحتمال الذي يبرِّئ المرأة، مع علمه المسبق أنها مذنبة، وذلك حتى لا يتهمه أحد بأنه متحيِّز ضدها، أو أنه يُصدِر قراره عن انطباع سابق. . ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾[يوسف: 28]: بين كيد النساء وكيد الشيطان! وصف العزيز كيد النساء بأنه عظيم، بينما وصف الله كيد الشيطان بأنه ضعيف، ولا يلزم من ذلك أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، بل الحق أن كيد الشيطان أقوى، وما كيد النساء إلا جزء من كيد الشيطان، وناشئ عن وساوسه. . ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾[يوسف: 29]: ما معنى الاستغفار إن لم يقترن بتوبة؟ والتوبة تقتضي ترك مقدمات الذنوب، والخلوة من هذه المقدمات وكذلك التبرج، وبقاء هذه المقدمات مع طلب الاستغفار حرث في بحار وعلامة استهتار. ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾[يوسف: 29]: والخاطئ غير المخطئ، فالخاطئ هو الذي تعمَّد الخطأ لا الذي وقع فيه رغما عنه، وقد خطَّطت المرأة ودبَّرت وغلَّقت وتهيَّأت في سبيل أن تظفر بهذا الذنب، فلذا خاطبها بهذا الوصف. . ﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ﴾[يوسف: 32]: جلد الفجار في نيل الأوزار وشراء النار! قسَمان اثنان في آية واحدة: ﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿وَلَئِنْ﴾ مما يدل على تصميم المرأة على المضي قدُما في فسادها وإفسادها.. . ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾[يوسف: 37]: استعمل يوسف مواهبه التي وهبها الله إياه في تعريف الناس بربهم ودعوتهم إليه، فهلا تعلَّمناها من يوسف! . ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾[يوسف: 37]: لم يقل لهم: اتركوا ملة القوم، بل عبَّر بقوله: ﴿تَرَكْتُ﴾، وفيه لطف في النصح وتورية، وكأنه كان على دينهما، فلما تركه آتاه الله هذا العلم، ترغيبا لهما في ترك ملة الكفر.  . ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾[يوسف: 37]: لم يقل لهم: أنتم كافرون، فيزيدهم ذلك إعراضا وعنادا، بل جعل الحديث عن قوم آخرين، وهو من لطفه وحسن عرضه لدعوته على طريقة: إياكِ أعني فاسمعي يا جارة. . ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾[يوسف: 38]: انظر كيف قدَّم الدعوة على تأويل الرؤيا، واستغل الفرصة لينشر دعوته ويبلِّغ رسالته. . ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾[يوسف: 38]: أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة التوحيد والإيمان به، وهي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، لذا لا يؤدون شكرها؟! . ﴿يا صاحِبَي السِّجْن﴾[يوسف: 39]: النصيحة دواء مرٌّ، فلابد أن يسبقه كلام حلو. . ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾[يوسف: 42]: من لطف الله وتدبيره الخفي أن أنسى الشيطانُ الساقي ذكرَ يوسف عليه السلام، فقد أراد الله أن يرتبط خروج يوسف بظهور براءته، فلو كان خرج عن طريق الساقي لظلت التهمة الأولى ملتصقة به. ﴿إلا على الله رزقها﴾: لم يقل: رزقها على الله، وتقديم على الله قبل كلمة رزقها لإفادة القصر، أي على الله لا على غيره، و (على) تدل على اللزوم، ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد بشيء، فأفاد معنى اللزوم ضمان الرزق لكل الخلق، لأن الله إذا وعد وجب وقوع الموعود. ﴿ويعلم مستقرها ومستودعها﴾: قال ابن مسعود: مُسْتَقَرُّها: الأرحام، ومُستوْدعها: الأرْض الَّتي يموت فيها. . (وضائق به صدرك) : قال ابن جزي: وإنما قال ضائق، ولم يقل ضيق؛ ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه.  . {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى إِلَيْكَ} [هود: 12] : وهو استفهام في معرض النهي، فإياك أن يضيق صدرك فلا تُبلغهم شيئاً مما أنزِلَ إليك. . ﴿ويتلوه شاهدٌ منه﴾: ليس معنى يتلوه هنا من التلاوة؛ بل المعنى هنا: يتبعه. ﴿وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا﴾: عندما تغدو الدنيا معيار التميز؛ يتحول الأفضل إلى الأرذل، والأتقى إلى الأغبى، والأقرب إلى الله إلى الأبعد عن الناس. . ﴿ما نراك إلا بشرا مثلنا﴾: عندما تغيب الموضوعية، ينصرفون عن الكلام إلى المتكلم، وعن القول إلى القائل، وعن الفكرة إلى صاحبها. . ﴿وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا﴾:قال القرطبي: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم، فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. . ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾: اتهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوحا بالسطحية. قال ابن جزي: «أول الرأي من غير نظر ولا تدبير، والمعنى: اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت». ﴿وآتاني رحمة من عنده فعُمِّيت عليكم﴾: العمى الحقيقي هو ألا يبصر قلبك رحمات الله المنزلة.  ﴿ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم﴾: مجرد طرد المؤمنين يستوجب عقوبة الله، فكيف بسجنهم وإيذائهم؟! . ﴿الله أعلم بما في أنفسهم﴾: صدَق نوح عليه السلام: لا يستطيع أحد أن يحكم على (نية) غيره، فلا يعلم نوايا القلوب إلا علام الغيوب. . (فلا تبتئس) بما كانوا يفعلون" يا لعظمة تسلية المحزون .. الله يتولاها بنفسه. جزى الله خيرا كل من اقتسم معنا كسرة حزن. . (فلا تبتئس بما كانوا يفعلون): قال الرازي: «أي لا تحزن من ذلك، ولا تغتم، ولا تظن أن في ذلك مذلة، فإن الدين عزيز، وإن قلَّ عدد من يتمسك به، والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به». . لا تستطل طريق الدعوة، فنوح مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ولا تضجر من قلة من استجاب لك، فما آمن مع نوح إلا قليل. . ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور﴾: طوفان يخرج من تنور (فرن)!! درس إلهي: أستطيع أن أنصرك بالسبب، وبلا سبب، وبعكس السبب. ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها﴾: قال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل». ﴿ قال يا نوح إنه ليس من أهلك ﴾: صحَّح الله مفهوم الأهل لدى نوح عليه السلام، فالمؤمنون هم أهله. . ﴿يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين﴾ ولم يقل: مع الغارقين لأن مصيبة الدين هي أعظم المصائب. . (قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء): إذا جاء أمر الله فلا ينجي إلا الله، وإن لجأت إلى أعظم جبل، وإن كان أبوك خير البشر. |
|
|

|
|
|
#29 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
تعزية!
( قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عملٌ غير صالح ) قال القرطبي: في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. (قالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ): قال القرطبي: وقال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب .﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ : لماذا الصبر؟! قال ابن عاشور: »لأن داعي الصبر قائم، وهو أن العاقبة الحسنة ستكون من نصيب المتقين، فستكون لك وللمؤمنين معك. واللام في ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ للاختصاص والملك، فيقتضي امتلاك المتقين لجنس العاقبة الحسنة، فهي ثابتة لهم لا تفوتهم، ومنتفية عن أضدادهم من غير المتقين». . ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ : ما أجمل هذا الحديث: «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة». صحيح الجامع: 6026 . ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّه﴾: هذه معجزة هود، فقد تحدى أمته بأسرها أن يصبوا عليه كيدهم بلا تريث أو انتظار، وكان سر قوته ومصدر منعته: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّه﴾. . ﴿ إن ربّي قريبٌ (مُجيب) ﴾. يجيبُ دعوة عباده مهما كانوا، فيجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم ولو كان فاجرا، فكيف بالأبرار والأتقياء!  . ﴿فعقروها﴾: قال القرطبي: إنما عقرها بعضهم، وأضيف إلى الكل، لأنه كان برضا الباقين. . ﴿مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد﴾: هذا قانون التماثل، وهو تهديد للظالمين الحاليين، بأنهم ليسوا بعيدين عن عقوبة الظالمين السابقين، لاشتراكهم في نفس الجريمة. . ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾: هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم حقيقي، فالصلاة تأمر صاحبها وتنهاه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا كانت مظهرا بلا جوهر. . ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: مال قليل مبارك خير من كثرة مال غير مباركة! قال القرطبي: «أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة، وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم». ﴿فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ﴾: قال ابن عباس رضي الله عنه: «ما نزل على النبي ﷺ آية كانت أشق ولا أشد من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ﴾: ، ولذلك قال ﷺ لأصحابه حين قالوا: أسرع إليك الشيب. قال: «شيبتني هود وأخواتها». . ما معنى الاستقامة؟! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب».  . ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾: قال القشيري:«لا تعملوا أعمالهم، ولا ترضوا بأعمالهم، ولا تمدحوهم على أعمالهم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف لهم، ولا تأخذوا شيئا من حرام أموالهم، ولا تساكنوهم بقلوبكم، ولا تخالطوهم، ولا تعاشروهم ... كل هذا يحتمله الأمر، ويدخل تحت الخطاب». . ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾: قال السعدي: وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية. . ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾: التوكل من عبادة الله، لكن خصه الله بالذكر اهتماما به، فهو نعم العون على سائر أنواع العبادة، فهو سبحانه لا يُعبَد إلا بمعونته. . ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾: الحق الأعزل بلا قوة لا تأثير له ولو كان صاحبه نبيا، فلابد للحق من قوة تحميه. . ﴿ِإنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾: قالها شعيب لأمة وثنية، لكنه أقرَّ برخائهم ورغد عيشهم، فالإنصاف سمة المصلحين، وهم أبعد ما يكونون عن تشويه الحقائق أو الكذب لينصروا قضيتهم. . فصل الدين عن الحياة وواقع الناس ليس أمرا جديدا، بل له جذور قديمة، وهي سُنّة جاهلية: (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء). . ﴿وما توفيقي إلا بالله﴾: قال ابن القيم: «وقد أجمع العارفون على أَن كل خير، فأصله بِتوفيق الله للْعَبد، وكل شَرّ فأصله خذلانه لعَبْدِه، وأَجْمعُوا أَن التَّوْفِيق أَن لَا يكلك الله إلى نفسك». الظلم إعلان حرب مع الله، وتنتهي بانتقام الله: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد). (وكذلك أخذ ربك): قانون التماثل مرة أخرى، فمن سلك نفس طريق الظالمين نال نفس عقوبتهم. أمر الله رسوله بالاستقامة وفق أمره، فقال: ﴿ فاستقم كما أمرت﴾، فنحن أحق بالنظر في استقامتنا، وهل هي وفق ما أراد الله أم لا. إكثار المرء من الحسنات هو سبيل محاصرة السيئات والتغلب على تغلغلها في القلوب (إن الحسنات يذهبن السيئات). (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ): المصلحون صمام أمان للمجتمع لا الصالحون، فإن قل عددهم أو حوصروا فقلَّ تأثيرهم، فهي نذُر الهلاك.  ﴿وما كان ربُّك ليُهْلِكَ القُرى بظلمٍ وأَهلُها مُصْلحُون﴾: لا يكفي أن تكون صالحا سلبيا لتنقذ أمتك بل لابد أن تكون مصلحا إيجابيا. ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك): من أهم أسباب الثبات مطالعة سير الصالحين والأنبياء، وليس أفضل من مطالعة ذلك في خير الكتب: كتاب الله. (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) من إحياء وإماتة، وهداية وضلال، وصحة ومرض، ونصر وهزيمةـ فكل هذا يرجع إلى الله، إلى علمه وقدرته. ﴿قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾: قال الألوسي: وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله تعالى، وليحدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ومن شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره» .وصح عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه».رؤيا المؤمن تسرُّه ولا تغُرُّه، أي يستبشر بها لكن لا تقعِده عن العمل والأخذ بالأسباب من الحكمة كتمان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾.  ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين انظر كيف خدعهم الشيطان! السعدي: «فقدَّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطا من بعضهم لبعض». ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾: لا تنخدع بحيل المحتالين! قال الشعبي: كنت جالسا عند شريح إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب، وتبكي بكاء شديدا، فقلت: أصلحك الله، ما أراها إلا مظلومة. قال: وما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل؛ فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم له ظالمون. (والله غالب على أمره): جاءت الجملة بالسياق الاسمي، ولم ترد بالسياق الفعلي، فلم يقل الله: (ويغلب الله)، وذلك لأن هذا الحكم كالقانون الذي لا يتبدل مع يوسف عليه السلام أو مع غيره. عجيب أن تأتي هذه الآية عقب ذكر بيع يوسف كعبد يخدم في قصور الملوك، ففي أشد اللحظات قسوة يأتى ذكر أعظم البشارات، وكأن الله يختصر القصة المطوَّلة للابتلاء والتمكين في آية واحدة، لتغرس اليقين بموعود الله وسط الأعاصير وأوقات الزلزلة. (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ):(والله غالب على أمره): الناس لا يرفعون ولا يضعون، ولا يقدِّمون ولا يؤخِّرون، ولا يقرِّبون ولا يُبعِدون لأن الأمر كله بيد الله. قال أبو السعود:« لا يعلمون أنَّ الأمر كذلك، فيأتون ويذرون زعما منهم أنَّ لهم من الأمر شيئا، وأنَّى لهم ذلك! وإن الأمر كله لله عز وجل، أو لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه»
|
|
|

|
|
|
#30 |
|
مشرفة قسم القرآن
      |
الجزء الثالث عشر قال ابن تيمية: «إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول الباطل فيه بلا دليل، ونسبته إلى ما نزَّهَه الله منه». ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [يوسف: 56]: وما أحسن قول البحتري يواسي المسجونين ظلما:أما في رسول الله يوسف أسوة .. لمثلك محبوسا على الجَوْر والإِفك أقام جميل الصبر في السِّجن برهة .. فآل به الصبر الجميل إلى المُلْكِ ﴿ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 59]: إتقان التخفي! نكَّر يوسف الإشارة إلى أخيهم، فقال:﴿ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ﴾، فلم يقل: (ائتوني بأخيكم)؛ لأن التعريف يفيد سابق المعرفة، بخلاف التنكير، ولو فعل، لأثار الشكوك في نفوسهم، ولن يستبعدوا حينها أنه يوسف أخوهم. ﴿ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 59]: لماذا لم يطلب يوسف الإتيان بأبيه يعقوب؟! قال أبو حيان: «وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام معهم أنه بوحي، وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه، لكن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته، ولتتفسر الرؤيا الأولى». . ﴿سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾[يوسف: 61]: ولم يقولوا أبانا، إشارة إلى الحاجز النفسي الذي بينهم وبين أخيهم لأبيهم، فاستعمال ضمير المفرد الغائب بدلا من ضمير جماعة المتكلمين معبِّر عن نار حقدهم التي لم تنطفئ. ﴿حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ [يوسف: 66]: ما هذا الموثق؟! هو يمين الله وعهده، فطلب منهم أبوهم أن يجعلوا الله شاهدا عليهم، بأن يقولوا مثلا: لك منا ميثاق الله أو عهد الله، وقد جعله موثقا، لأنه تُوثَّق به العهود وتؤكَّد.  ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: 70]: كيف جاز ليوسف أن يروِّع أخاه بنيامين بغير وجه حق؟! والجواب: كان هذا بالاتفاق معه. قال ابن كثير: «وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معزَّزا مكرَّما معظَّما». . ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾[يوسف: 76]: معناه أن كل عالم هناك مَنْ هو أعلم منه، فيوسف عليه السلام أعلم من إخوته، وفوق يوسف الأعلم منه، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل. . ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: 77]: قولهم: ﴿أَخٌ لَهُ﴾ إصرار منهم على اعتبار يوسف وأخيه جبهة مستقلة عنهم، فزعَموا أن السرقة ليست غريبة على بنيامين، فإن أخاه الذي هلك كان أيضا سارقا! وهما ضالعان في السرقة لأنهما من أم أخرى غير أمِّنا، وقد اقتدى الأخ بأخيه، ولاشك أن الاشتراك في الأنساب يؤدي إلى الاشتراك في الأخلاق! . ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: 77]: من الكلام ما هو أشد وقعا على المرء من الحسام! . ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: 77]: رمتني بدائها وانسلَّت! كذبة جديدة يفترونها على يوسف، فينعتونه بالكذب وهم الكاذبون، وكأنهم لم يكذبوا من قبل على أبيهم في شأن يوسف مع الذئب. نفوس عجيبة!  . ﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾[يوسف: 77]: غالبا ما تأتي كلمة: ﴿تَصِفُونَ﴾ في القرآن للتعبير عن الكذِب، كقوله تعالى: ﴿سبحانه وتعالى عما يصِفون﴾، فيوسف أسرَّ في نفسه هذا القول: الله يعلم كذب اتهامكم لي بالسرقة، وأني وأخي برءاء مما تدَّعون. . ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ﴾ [يوسف: 79]: ما يفعله بعض الظلمة من إلقاء القبض على بعض أقارب المتهم حتى يسلِّم نفسه هو عدوان لا يقره شرع ولا عرف. . ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ [يوسف: 81]: اتفق العلماء على أن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لذا يستند الحكم على البيِّنة وشهادة الشهود وغيرها من أحكام الظاهر، ولو كان الباطن والحقيقة على خلاف ذلك. . ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: 81]: آفة الأخبار رواتها، فلا تنقل إلا ما رأيتَ وتأكدت من صحته، وأكثر الناس يحدِّث بما فهم لا بما سمع أو رأى، وفارق شاسع بين الأمرين. . ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: 83]: كيف اجتمعت مرارة الصبر مع الجمال؟! والجواب: ليس هذا حاصلا إلا في نفوس الموقنين، فإن حلاوة الأجر لديهم طغَت على مرارة الصبر. ﴿قال إنما أشكو بثِّي وحزني إلى الله﴾ [يوسف: 86]: قال ابن تيمية: «أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق: إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، ومتى احتجت إليهم - ولو في شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم». ﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾ [يوسف: 88]: ما أبأس الحال التي وصل إليها إخوة يوسف! وصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة، ومعنى المزجاة على خمسة أقوال: قليلة أو رديئة أو كاسدة أو رثَّة أو ناقصة، والبضاعة المزجاة من مظاهر الضُّر الذي نزل بهم، وقدَّموا هذا الوصف لترقيق القلوب بين يدي طلبهم للطعام. . ﴿قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ﴾[يوسف: 91]: هنا كانت بداية الإفاقة لهم جميعا! وقد جمعوا بهذا القسَم بين فضيلتين: الإقرار ليوسف بالفضل، والاعتراف بالخطأ. . ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾[يوسف: 111]: لن تعيش مئات الأعوام، لكنك تستطيع الحصول على خبرة مئات الأعوام، وذلك بالنظر في قصص السابقين وتجارب الماضين، وصدق الشاعر:. ليس بإنسانٍ ولا عاقل .. من لا يعي التاريخ في صدره . ﴿المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[الرعد: 1]: أخبر عن االقرآن بأنه الحق بصيغة القصر، أي هو الحق لا غيره، فلا اعتداد بغيره من الكلام إذا تعارض معه.  . ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[الرعد: 3]: آيات الله مبثوثة حولك في كل مكان، لكن دون التفكر لن تصل إلى كنزها المخبوء وثمرتها الجنية. قال أبو الدرداء: تَفَكُّر ساعة خير من قيام ليلة. . ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾[الرعد: 4]: الصنو: النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى، نابتتين في أصل واحد أو نخلات، الواحد صنو، والمثنى صنوان. . ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾[الرعد: 4]: ماء واحد وتربة واحدة، وطعوم مختلفة، ومذاقات متنوعة، ليس واحد منها يشبه الآخر. . ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾[الرعد: 10]: قال ابن عباس: «هو صاحب ريبة (إثم) مستخف بالليل، وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم». . ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾[الرعد: 12]: البرق صديق المؤمن، أهداه لكل مؤمن هديتين، الأولى: بذر الخوف من الله في قلبه، والثانية: تبشيره بالمطر.  . ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾[الرعد: 12]: هي المثقلة بالماء. لا تستبطئ الفرَج؛ فإن العرب تقول: أبطأُ الدلاء فيضا أملؤها، وأثقل السحاب مشيا أَحفلُها (أي بالمطر). . ﴿إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾[الرعد: 14]: كل من دعا غير الله في دفع ضر أو جلب منفعة، فهو كالقابض على الماء، لا يبقى في كفه منه شيء. ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾[الرعد: 16]: قال مجاهد: «أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن، وأما الظلمات والنور فالهدى والضلال». . ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾[الرعد: 16]: الاستفهام هنا للتهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار بهم واتخاذهم آلهة، أما اليوم فلا عذر لهم في عبادتهم. الحسنى هي المنفعة العظيمة في الحُسْن، وهي المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة، والدائمة الخالية عن الانقطاع، المقرونة بالتعظيم والإجلال، وهذه لا تكون إلا في الجنة. قال ابن عباس في هذه الآية: الحُسْنى: الجنة. . ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى﴾[الرعد: 18]: على قدر استجابتك لأمر الله، يكون حسن جزائك ومثوبتك، فاستشرف مُلكَك المستقبلي. . ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾[الرعد: 18]: قال إبراهيم النخعي: «سوء الحساب أن يُحاسَبَ الرجل بذنبه كله لا يغفر له من شيء». . ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[الرعد: 19]: كل من لا يرى الحق في الوحي، فهو مسلوب العقل. . ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[الرعد: 19]: إِذا لم يَكُنْ للمرء عَيْنٌ بَصِيرَةٌ ... فلا غَرْوَ أن يرتاب والصُّبح مُسْفِر . ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾[الرعد: 20]: ﴿ولا ينقضون الميثاق﴾ تعميم بعد تخصيص، لتشمل عهودهم مع الله ومع غيره من عباده. . ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾[الرعد: 25]: قال قتادة: فقطَع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة الرحم والقرابة. ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾[الرعد: 25]: اللعنة من الله هي الإبعاد من خيري الدنيا والآخرة إلى ضدهما من عذاب ونقمة، وسوء الدار هي جهنم، وليس فيها إلا ما يسوء داخلها. . ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾[الرعد: 26]: ليس بالضرورة أن ما أفرحك في الدنيا يسعدك في الآخرة . ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾[الرعد: 27]: إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة البأس في الكفر، فلا سبيل إلى اهتدائهم، وإن أنزل الله عليهم كل آية، ويهدي الله إليه مَنْ كان على خلاف صفتكم، ممن أقبل على الحق. . ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾[الرعد: 28]: هجرك الذكر هو ما جعل قلبك مرتعا للقلق والهموم؛ وإقبالك على الذكر هو دواؤك، وفيه شفاؤك. . ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[الرعد: 29]: طابت في الدنيا أوقاتهم، فطاب في الجنة مقامهم، فطوبى لهم في الحال، وحسن مآب في المآل. . ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[الرعد: 29]: طوبى لمن قال له الله: طوبى. . ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ ﴾[الرعد: 30]: يكفرون بالذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته إنزال الوحي الذي هو سبب المنافع الدينية والدنيوية.  . ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ ﴾[الرعد: 30]: كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم، لذا خصَّه الله بالذكر هنا، ولذا لم يرضوا يوم الحديبية أن يكتبوا: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم؟! . ﴿وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾[الرعد: 30]: المتاب: أي التوبة، والمتاب يتضمن معنى الرجوع إلى ما أمر الله به، لذا استعمل معه حرف: ﴿إِلَيه﴾. . ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾[الرعد: 31]: ما أبرد وقع هذه التسلية على القلب! تسلية بما جرى في الماضي للأنبياء من استهزاء، فلست الأوحد في هذا الميدان، وأبشِر بسوء عاقبة المستهزئين في كل العصور والأزمان. . ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾[الرعد: 34]: أشد الناس بؤسا من فقد الراحة في الدارين. . ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ ﴾[الرعد: 35]: إذا نزع الرجل ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. . ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾[الرعد: 35]: دوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا يوجد بينها فراغ تنفذ منه الشمس، كما قال في سورة النبأ: ﴿وجنات ألفافا﴾ [سورة النبأ: 16].  . ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾[الرعد: 39]: من آثار المحو محو الوعيد بأن يلهم المذنبين بالتوبة، ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن التوبة. ﴿وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾[الرعد: 40]: هلاك أعداء الدين قد يراه النبي ﷺ، وقد يؤخرهم الله إلى الآخرة حيث العذاب الأشد. ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾[الرعد: 42]: هذا سبب من أسباب أن مكر الله أشد من مكر كل نفس: أنه يعلم ما تكسب كل نفس، ما ظهر منه وما بطن، فلا يفوته شيء مما تضمره نفوس الماكرين، لذا يبطل كيدهم، بعكس البشر، فقد تجد منهم القوي الشديد، لكنه لا يعلم الغيب، لذا قد يغلبه الضعيف بحيلته. ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾[الرعد: 42]: ما الذي يترتب على علم الله؟ يعلم ما تكسب كل نفس، ويجازي كل نفس بما كسبت. ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾[الرعد: 42]: علم لا ينفع، لأنه في الوقت الضائع. . ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 43]: قال ابن كثير: «﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ﷺ ونعته في كتبهم المتقدمة، من بشارات الأنبياء به». . ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾[إبراهيم: 14]: خير ما يمنع العبد من الظلم اليوم: خوفه من مقامه غدا بين يدي الله. |
|
|

|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مائة فائدة في النحو والإعراب كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 11-04-2023 04:03 PM |
| أكبر مكتبة تسجيلات قرآنية صوتية ومرئية فى العالم 53000 تلاوه لجميع القراء والمشايخ | أبو ريم ورحمة | ملتقى الصوتيات والمرئيات والفلاشات الدعوية | 1 | 01-10-2019 06:59 AM |
| التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 11-20-2017 05:09 PM |
| زوال إسرائيل حتمية قرآنية كتاب تقلب صفحاته بنفسك | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 3 | 04-19-2017 11:39 AM |
|
|